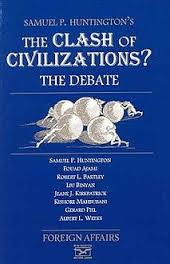ديسمبر
22
الإرهاب في أوروبا… نقمة الآيديولوجيا على الحضارات
فهد بن سليمان الشقيران
جريدة الشرق الاوسط 22 ديسمبر 2016

منذ فبراير (شباط) من هذا العام شهدت ألمانيا صنوفًا من الإرهاب المنظّم. من طعن الشرطي، إلى حادثة معبد السيخ، مرورًا باعتداء شاب هارب من أفغانستان على ركاب أحد القطارات. ولم تنتهِ عند أحداث قتل واغتيال للشرطة، وتسريب فيديوهات تهدد الألمان بـ«الانتقام». معلوم أن ألمانيا غامرت بإيواء قدرٍ كبيرٍ من اللاجئين، مما منح أصوات اليمين مشروعيةً بالطرح، بوصفها حاميةً للهويّة الأصلية، ومدافعة عن ألمانيا قومًا وجذرًا، وهو تحوّل بالثقافة الألمانية الباردة تجاه الأجنبي وذلك ضمن اعتياد ثقافي ورسم قانوني.
الصوت المناوئ للاجئين والمهاجرين أخذ تصاعده بعد حادث الدهس بسوق عيد الميلاد ببرلين، الذي أودى بحياة اثني عشر شخصًا، وأكثر من أربعين جريحًا. ردة الفعل الأكثر دويًا كانت من حزب البديل لأجل ألمانيا «إيه إف دي» المعارض للاتحاد الأوروبي والمعادي للاجئين، حيث دعا صراحةً إلى: «تطبيق حظر فوري على دخول أي أشخاص غير معروفي الهوية إلى ألمانيا».
كل هذه التعليقات تعيدنا إلى مشكلة الهويّة الإسلامية، وعلاقتها مع الهويّات الأوروبية الأخرى.
لقد شكّلت عواصم أوروبية في الثلث الأخير من القرن العشرين جنةً باردةً لرموز الإسلام السياسي، مستغلين الحريات، ومتسللين من «روح القوانين» على حد تعبير مونتسكيو. استغلوا الحقوق، واستفادوا من القيم الأوروبية، المتيحة للغريب فرص العودة إلى هذه الديار حين يخر السقف من فوقهم، أو تضيق بهم ديارهم، أو تطاردهم حكوماتهم، أو تزلزل الأرض من تحتهم.
غير أن المرحلة لن تطول، وآية ذلك أن البركان النقدي ضد المهاجرين والغرباء والمتطرفين قد تفجّر بفرنسا منذ أحداث «شارلي إيبدو». على سبيل المثال، نشر آلان غريش رئيس التحرير السابق لـ«لوموند ديبلوماتيك» بعد الحادثة كتابًا بعنوان: «الإسلام، الجمهورية، العالم» المؤلف مشهور بانتمائه اليساري. مباشرةً وبعد أن افتتح الكتاب بقراءةٍ لحادثة «شارلي إيبدو»، خصص أبوابًا عن «حرب وصدام الحضارات» تضمّن بالطبع أمنيات ومواعظ حسنة للساسة والحكومات الغربية بأن يكونوا جيدين تجاه المسلمين، لأنهم غير مضرّين، ومن يمارس الأعمال الإرهابية لا يمثلهم.
يردّ غريش بالكتاب على أطروحة برنارد لويس التي تقول: «إن الحقد يذهب إلى ما هو أبعد من حالةِ العداوة إزاء بعض المصالح أو الأعمال الخاصة، أو حتى إزاء بلدانٍ معيّنة، ليصبح رفضًا للحضارة الغربية كما هي، وهو كره ليس لما تفعله فقط، وإنما لما هي عليه وللمبادئ والقيم التي تطبقها، أو تجاهر بها». يردّ غريش: «هذا التصوّر يستتبع أن لا جدوى من إيلاء الأولوية لإزالة الظلم الذي يعصف بالعالم الإسلامي كما في فلسطين أو العراق، أو حالة المشكلات الاجتماعية». ثم سرعان ما يعترف بأن المسلمين مهما فعلنا فهم يكرهون الغرب!
هذا الاتجاه من المؤلف هدفه غبن الحضارة الغربية باعتبارها شريكةً في التصوّر التقليدي عن أوروبا، وهو هارب من نقاش الجزء إلى الكل، ومن التفاصيل إلى العموميات، لم يتطرّق إلى أدوار عودة الهوية، وأسس الاستقبال الإسلامي للحضارة الغربية؛ ذلك أن الآتي إلى إحدى عواصمها يدلف المدينة وبجعبته مشروع لإصلاح أوروبا وتفصيلها على مقاسه هو ولو بالسلاح. كانت هناك مداراة أخلاقية للمهاجرين، وبخاصة ما يتعلق بالطعام، والحجاب، وأماكن العبادة، والدعوة للإسلام، وبناء المراكز الإسلامية، وفسح المجال للجمعيات الخيرية… تبيّن فيما بعد أن كارثة كبرى قد نسيت طوال أكثر من ثلاثة عقود في فرنسا وبريطانيا تحديدًا، وفي هذا درس لألمانيا تجاه فاعليتها مع أعمال الإسلام السياسي، ذلك يحتاج إلى وعي دقيق واستيعاب لتجارب دول الجوار.
لكن ما هي الكارثة التي حلّت على حين غرّة؟!
الكارثة التي حلّت أن الصراع كان خفيًّا بين الآيديولوجيا الزائرة، والحضارة القائمة. صراع يبدو في الثيمات والعلامات، بالرموز والإشارات، بالألبسة واليافطات، كانت الصورة النمطية عن الخطب والتحركات والآراء والألبسة والأزياء أنها «آراء أخرى» ولأن الحضارة الأوروبية بصمتها الأساسية التي صارعت لأجلها طوال خمسة قرون هي «الفردية» واحترام «الغيرية» منذ هيغل وحتى ليفناس.
كان لدى داريوش شايغان كراسة صغيرة طبعت بباريس عام 1992 وترجمت للعربية عام 1993 بعنوان «أوهام الهويّة» وأشار إلى هذا الصراع كاتبًا: «إن الحضارات غير الغربية لم تشهد هذه التغييرات بل تلّقتها بالوكالة، لم يكن من سبيلٍ إلى أصل الفكر الغربي وفصله، ولا إلى حركته الديالكتيكية، بحيث غدت الآيديولوجيا بمعنى ما الشكل الوحيد المتيسّر للحضارات غير الغربية، وبه تمكنت من الاضطلاع بدورٍ ما بالتاريخ». من قول شايغان هذا تستبين حالة التعويض عن الفقر الحضاري بتشجيع الآيديولوجيا المعتادة على الصراع وأساس بنائها معتمد دائمًا على نتائج ومبادئ مفعمة بـ«النزق الفكري».
مارست آيديولوجيا الإسلام السياسي بأوروبا حماقات الإصلاح بدلاً من حضاريّة التكيّف، من الممكن بالنسبة لأوهامها القيام بإصلاحات من خلال نفوذ في برلمان الدولة، وتغيير القوانين. كانت هناك غيبوبة حكومية رسمية منذ السبعينات عن مؤسسات الإسلام السياسي التي وصلت إلى فيينا، وسويسرا، تلك كانت غلطة فظيعة جرّت ويلاتٍ على الأوروبيين، وأي ويلات؟!
لن نتحدث عن نماذج متشددة مشهود لها بالجهل مثل أبو حمزة المصري، بل عن كاتب يقدّم بوصفه مفكرًا وله أطروحة عن نيتشه ويتحدّث عن الهويّة الفرنسية مثل حفيد حسن البنا طارق رمضان الذي كتب عن فرنسا قائلاً: «إن الأمر بنهاية المطاف يتعلق بتصوّرنا لمفهوم الهوية، فإذا كنا نعتقد أن التاريخ يغير المجتمعات والبشر، فيجب أن نقبل بتطوّر هويتنا الجماعية، من المشكلات التي تطرحها بعض التيارات الفكرية والسياسية في فرنسا هي المطالبة بهويّة فرنسية، والمطالبة حتى بفرنسا التي لم تعد توجد، بفرنسا التي لم تتطوّر».
إذا بقيت أوروبا ملاذًا ومنطلقًا لعمل الإسلام السياسي ورموزه فإن التطرّف سيزداد، لكن بحال تم لجم هذا التغول قانونيًا وسياسيًا فإن الخطر سيتضاءل، صرخ مرةً أستاذ فرنسي بكتابٍ لم يعجب آلان غريش حمل عنوان: «فرنسا حاذري فقدان روحك» لإيمانويل برينيه… قد يصحّ هذا النداء القاسي على بقية الدول الأوروبية وعواصمها قاطبة.
ديسمبر
15
مأساوية حلب… حين كُسر «العظم»
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 16 ديسمبر 2016
بالتزامن مع أنهار من دمٍ تنزف في حلب؛ المدرعات من تحتهم، والبراميل والطائرات من فوقهم رحل المفكر السوري صادق جلال العظم. ساند الثورة السورية منذ البداية، وخاض معارك طاحنة مع أدونيس حول الصراع على مرجعية الثورة السورية بين «الجامعة» و«الجامع». رحل بعد زميليه جورج طرابيشي ومطاع صفدي، كلهم أدمتهم الثورة السورية وكتبوا حولها طامحين وراغبين، أو مدافعين ومحللين، وتاراتٍ أخرى باحثين ومتسائلين.
طوال سنوات الأزمة السورية المؤلمة تشكّل النقاش بين نخب البلاد على اتجاهين اثنين؛ خطّ المؤيد للثورة، والمدافع عن حق الناس بالحريّة، وضرورة إسقاط النظام حتى وإن كان البديل السياسي حكمًا إسلاميًا محضًا. يعتبر أهل هذا الرأي أن الثورة بحد ذاتها غاية وفضيلة من أجل نيل الحرية. كان العظم قريبًا من هذا الرأي في لقاءاته المتلفزة ومناظراته.
بينما الوجهة الأخرى تعتبر الثورة وسيلة لتحقيق غاية، ومن دون الترتيب للمآلات المضمونة لن يكون هناك تأييد لها، وشرط تأييد الثورة بالنسبة لهؤلاء الوصول إلى نظامٍ علماني، والنقاش حول وضع المرأة، وضمان عدم إقامة حكم ديني، والإعلان عن المساواة بين الطوائف والأديان بسوريا، ومن عرّابي هذا القول أدونيس، الذي نشبت بينه وبين العظم سجالات بلغت ذروتها حين اتهم العظم خصمه «باستيقاظ شيعيته»، تلك الذروة من التهم تبيّن المستوى الطائفي حتى بين شخصيتين علمانيتين وفلسفيتين، ومناوئتين منذ نصف قرن لتيارات العنف، ومجتمعات الطوائف.. سجال وضّح المستوى الطائفي بين النخب، فضلاً عن حضور التصفية على المذهب والقتل على الهويّة بمناطق في سوريا.
رتّب العظم أوراقه الأكاديمية والفلسفية منسجمًا مع النزعة الماركسية، وأخذ خياراته السياسية والدينية منطلقًا منها، محجّمًا من الدور الفردي على المستوى العربي، ومغلّبًا النزعة الجماعية، ضمن طموحه التاريخي بثورة شاملة تجتاح المعيارية التفسيرية للأفكار الدينية، متأثرًا بالتحوّلات الفلسفية الغربية من الماركسية المعدّلة، إلى الوجودية «الموضة» شارحًا بملفٍ واسع رمزها الدنماركي كريكغارد، وفي بحثه عن بيرغسون أراد إيجاد الروابط بين التصوّف بتجربتيه المسيحية والإسلامية، وبمقدمة كتابه المهم «دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة» تكتب تلميذته د. نجلاء حمادة مقدمةً له، وتشرح كيف أن «الجرأة في خوض المعارك الصعبة، ومواجهة عمالقة القهر والجهل، والعقلانية والالتزام، ما فتئت ترافق العظم وتواكبه في جميع أعماله، ومن الثوابت في فلسفة العظم كما في حياته، ماركسية تجد فيما يعيشه الإنسان لا ما يقول به أو يكتبه، المعبّر الصادق عن قناعاته ومعتقداته وهذه ثابتة ما فتئ العظم يجسّدها ويدفع أثمانها بطيبة خاطر».
منذ أواخر الستينات أخذ العظم على عاتقه التأسيس للثورة المنشودة؛ ألف كتابه الذي شكّل الحدَث والحديث معًا، حين أصدر عام 1969 «نقد الفكر الديني» ليدخل في نقاشٍ مع مرجعياتٍ دينية بلبنان. حرّك المفتي حسن خالد دعوى ضده، وخاض نقاشاتٍ مع محمد مهدي شمس الدين، وموسى الصدر، ودخل في حوارات ندّية مع كمال جنبلاط وكان حينها وزيرًا للداخلية وساهم في حمايته من السجن الطويل، ليكتب من بعد ذلك حول الاستشراق معكوسًا، وعن ذهنية التحريم، تمثّل المبدأ الماركسي أن تغيير التفكير الديني هو المدخل الرئيسي لأي نقد، وبقي حتى آخر حواراته التلفزيونية مدافعًا عن ضرورة ذلك التغيير. ينضم العظم إلى صفدي وطرابيشي، مودّعين سوريا بلا أفقٍ منظور. اختلفت توصيفات كل منهم طبقًا لتنوع أدواتهم الفكرية والفلسفية، بيد أن الثابت الرئيسي بينهم كان الأمل بسوريا جديدة، لكن ومع هذا الطحن الاستثنائي غير المسبوق، والوحشية الكارثية التي تجرب في حلب لا يظنّ المتابع أن ثمة ولادة أخرى لمستقبل أنصع، بل إن براكين طائفية ووحشية أخرى ستتفجّر على أثر ذلك الصراع. تمنّى العظم من صراع الطرفين أن ينتج مستقبل ثالث على الطريقة الديالكتيكية المحرّكة لشريط التاريخ.
رحلة العظم الممتدة لإنتاج استمر نصف قرن كانت محاولة جريئة عايشت عهود الاستقلال، وانكسارات العرب مع إسرائيل، وانحسار التنوير أمام مد التطرف ونشوء الجماعات المسلّحة، وكانت حلب آخر معارك العظم الدامية، إنها مأساوية تذكّر برثاء الماغوط ابن السلمية السورية حين رثى السياب:
«تشبثْ بموتك أيها المغفل
دافعْ عنه بالحجارةِ والأسنان والمخالب
فما الذي تريد أن تراه؟».
ديسمبر
04
شبح هنتنغتون…العالم ليس قرية واحدة
فهد سليمان الشقيران
الشرق الأوسط 1 ديسمبر 2016
النبرة التصاعدية للاعتداد بالهويّة والثقافة المركزية والدولة القوميّة بأوروبا باتت واضحة مع احتدام المنافسة الانتخابية في فرنسا. حظوظ اليمين الشعبية أخذت وهجها بعد الفوز المباغت لدونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، ولأن أميركا هي «بنت أوروبا» – كما هو تعبير شارل ديغول – فإن المراحل قد تتشابه وذلك لاعتبارات تتعلق بالمهاجرين، والإرهاب، وموقع الثقافة الإسلامية في المجتمعات الغربية. بلغت ذروة التصاعد ضد الهويّات الأخرى بإغلاق «تويتر» لحساب ميلويانوبولوس الكاتب العنصري بموقع «برايت بارت» الإخباري، وبتقرير عنه نشر في «DW.COM» الألماني، فإن المواد التي يحويها «موجهة ضد المؤسسات السياسية، وضد الديمقراطيين، والجمهوريين على السواء، كما يحوي في بعض الأحيان استخدامات لغوية جارحة ضد النساء والسود والمكسيكيين، أو اليهود والمسلمين».
بينما في فرنسا فاز مؤلف كتاب «التوتاليتارية الإسلامية» فرنسوا فيون بالانتخابات التمهيدية لليمين ويمين الوسط، المعروف بتعليقاته حول الإخوان المسلمين والإسلام السياسي، والمطالِب بتغليب مصلحة الأمن على حالة «التعاطف» مع اللاجئين!
كل ذلك سهّل العودة المحقّة إعلاميًا لأطروحة صموئيل هنتنغتون «صدام حضارات؟». أصلها مقالة مطوّلة نشرها مستفهمًا في «فورين أفيرز» عام 1993، في السطر الثاني من المقالة ذكر عبارة «نهاية التاريخ» عنوان مقالة لفرانسيس فوكوياما نشرت في العام 1989 بمجلة «ناشيونال إنترست» قبل تطويرها لكتابٍ عام 1992.
صموئيل هنتنغتون لم يتراجع عن نظرية الصدام حتى وفاته في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2008. وباستعادة بعض مضامينها يمكن الوقوف على مضامين فصيحة منها: «أفترض أن سبب الصراع الأساسي في هذا العالم الجديد لن يكون آيديولوجيًا بالمقام الأوّل، أو اقتصاديًا بالدرجة الأولى، فالانقسامات الكبرى بين بني البشر والأسباب الطاغية للنزاعات ستكون ثقافية… ستكتسب الهويّة الحضارية أهميّة متزايدة في المستقبل، وستتم صياغة العالم إلى حدٍ كبير، من خلال جملة التفاعلات الجارية بين سبع أو ثماني حضارات، هي الحضارات الغربية، والكونفوشيوسية، واليابانية، والإسلامية، والهندوسية، والسلافية – الأرثوذوكسية، والأميركية – اللاتينية، وربما الأفريقية، ستتم أكثر صراعات المستقبل أهمية على امتداد خطوط الصدوع الفاصلة بين الحضارات، إحداهما عن الأخرى… يصبح العالم أصغر، تتزايد التفاعلات بين أبناء الحضارات المختلفة، وهذه التفاعلات المتزايدة تؤدي إلى تكثيف الوعي الحضاري والإحساس بالفروق بين الحضارات والجماعات… هناك نتيجة مع تقدم الغرب، وهي نوعًا ما ظاهرة العودة إلى الجذور بين صفوف أبناء الحضارات الغربية… من غير المحتمل أن يتضاءل التفاعل القديم قدم القرون بين الغرب والإسلام، قد يصبح الاشتباك بين الطرفين أكثر ضراوة».
مع بلوغ العولمة ذروتها في المجالات الاقتصادية والتقنية، دأبت الماكينات الإعلامية على وصف العالم بالقرية الصغيرة وذلك إغراقًا في التفاؤل والاغتباط بما وصلت إليه المجتمعات من تعارف، وبسبب ازدياد التبادلات الاقتصادية الحرة، وغرق الفضاء بالأقمار الصناعية، وانفجار ثورة الإنترنت، وصولاً إلى انكسار الحدود بين الأمم، غير أن ما نبّه إليه هنتنغتون بوضوح أن صغر العالم قد يسبب ضربة للتعايش بين الحضارات، باعتبار التقارب والاحتكاك محفزًا لإدراك الفروقات، ومن ثم البحث عن الهويّة الخاصة، وخصائص الذات، ونقائص الحضارات الأخرى.
إن العولمة لم تعزز الفهم بين الأمم والأديان، بل حرست وكررت ونشرت الفهم التقليدي القائم عن الشعوب. وعلى المستوى الثقافي فإن المستفيد الأبرز من ثمرات العولمة التيارات المتطرفة عمومًا، وبخاصة «جماعات العنف الإسلامي» بشتى أنحاء العالم، التي ركبت ثبج التقنية واستخدمت أحدث خصائصها بغية الحرب على الآخرين، ورسم صورة دموية عن الحضارة الإسلامية ونجحت بذلك منذ ضرب البرجين في أحداث سبتمبر (أيلول)، وصولاً إلى أعمال «داعش» الوحشية، حتى كادت فروع تنظيم القاعدة تنافس فروع «ماكدونالدز»… نعم لقد عبرَت القارات.
استذكار مقولات هنتنغتون بعد طول سنين ضروري لفهم الذي يجري في الولايات المتحدة وأوروبا. يأتي في ذلك السياق الهوياتي كتاب أثار ضجّة كبرى بألمانيا عنوانه: «ألمانيا تفقد هويتها» من تأليف ثيلو سارازين عام 2010. المؤلف وزير مالية سابق وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي الألماني، رصدت ردود الفعل على الكتاب جاكلين سالم بكرّاسة مهمة لها بعنوان: «المواطنة الدينية في الغرب، تحليل لتجارب المسلمين في فرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة» تذكر أن خلاصة الكتاب تتمحور في الآتي: «المجتمع الألماني أصبح أقل ذكاءً، بسبب المهاجرين المسلمين وأولادهم» ويخصّ باحتقاره «الجالية التركية» بوصفها الأكبر بين المسلمين هناك.
الواقع قد يقسو على الأحلام، لكن هذه هي المرحلة المعيشة، إنها نتاج وحصيلة ظروف واشتباك. اليمين ستكون له صولاته وجولاته، والمرشحون يصدحون بالخطب كل يوم، والإسلام والمسلمون جزء أساسي من المضامين الخطابية. حين فاز دونالد ترامب علّق والد زعيمة حزب الجبهة الوطنية الممثل لأقصى اليمين الفرنسي جان ماري لوبان: «اليوم الولايات المتحدة، وغدًا فرنسا» ليردّ عليه نائب زعيم الجبهة فلوريان فيليبو: «عالمهم يتفتت، وعالمنا يبنى».
هكذا تسير الموجة اليوم… بالتأكيد العالم ليس قرية واحدة، تلك عبارة شعرية خاوية.