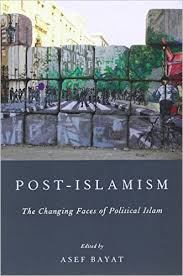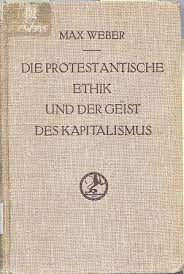مايو
26
الحركات الإسلامية و«العناوين العلمانية»!
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 26 مايو 2016
مثّلت تصريحات الغنوشي الأخيرة، وتوضيح التصريحات، ونفي بعض ما دخلها من إضافات، حديث المهتمّين بالظاهرة الإسلامية في العالم العربي، وذلك لما يمثّله الغنوشي الشخص على النهضة الحركة، ولما تضمّنه القول من مضامين جديدة على الحركة الإخوانية منذ تأسيسها حتى اليوم. محاولة ضخّ مفردات علمانية، وتمييز السياسة عن الدعوة، والقول بإمكانية الخروج بحركة النهضة من تنظيم الإخوان المسلمين كانت صدمةً بطبيعة الحال. تم استثمار التصريح من أجل إدارة معارك أخرى، كما في دعوة حركة فتح لقادة حماس للاستفادة من تصريحات الغنوشي، وأخذ العبرة من تجربة «حزب النهضة»، بينما أخذ التصريح صداه لدى بعض الليبراليين الذين تفتّقت عبقريات بعضهم التحليلية للحديث المستهلك حول تميّز «الإسلامية التونسية» عن بقية الحركات، وذلك تبعًا لظروف تشكّلها، وهذا مفهوم ومعروف، ولكنه لا يضيف شيئًا إلى موضوع الجدل نفسه، وهو التراجع في معنويات قادة الإسلام السياسي في المنطقة.
طوال السنوات الخمس الماضية كانت الحرب بين جماعة الإخوان المسلمين وحكومات عربية على أشدّها، معركة كسر عظم انتهت بانتصار المجتمع المصري على الحركة بثورة 30 يونيو (حزيران)، وبصدور قوانين تجرّم الانضمام إلى الجماعة في دولٍ عربية وخليجية، لم يعد ثمة فرق بين تنظيم الإخوان أو «داعش» أو «القاعدة»، كلها في قائمةٍ واحدة، والجرم هو الجرم. نزعت بعض القيادات إلى «تجديد التسميات»، من خلال إجراء ما يعتبرونه «القراءات المعمّقة»، هروبًا من عمليّة «التراجعات»، وانتقدت التجربة المصرية في الحكم من قياديين كبار في المنطقة، ومن بين منتقديها زعيم حركة النهضة نفسه راشد الغنوشي. لقد أصرّ الغنوشي، في «القراءة المعمّقة»، على مرجعية الإسلام والحداثة، وضغط كثيرًا على عبارة: «نحن حزب ديمقراطي، مدني، له مرجعيّة قيم حضارية»، لغرض إثبات حالة «خصوصية الحركة التونسية» عن بقيّة الحركات القريبة والمجاورة التي فشلت في الإدارة السياسية، وبخاصة التجربة الإخوانية المصرية التي كسرت ظهر الحركة، وأدخلتها في أخطر مراحلها منذ تأسيسها.
فكرة الخروج عن حركة الإخوان ليست إلا محاولةً لتجديد التسميات، والبحث عن عناوين جديدة، وشعارات أخرى تتجاوب والظرف المحيط، ولا يمكن تصوّر حركة إسلامية أو فرع منها يؤمن بمفهوم «العلمانية» بالمعنى العام، هذا ممتنع نظريًا وواقعيًا لأن الحركات هذه تكتسب قوّتها من تميّيزها لنفسها عن غيرها من الأحزاب الأخرى، وفي حال انصاعت إلى مبادئ غيرها، فإنها تنتحر سياسيًا وآيديولوجيًا، فالإسلام السياسي جوهري في العمل السياسي لحركة النهضة، ومنذ أن تأسست في سبعينات القرن الماضي وهي تنأى بنفسها عن «الزيتونة» على سبيل المثال، آخذةً من مرجعية الحركة الأم مرجعًا فقهيًا وفكريًا وسياسيًا، فالخروج من الإخوان، أو هجر الإسلام السياسي، عناوين ذكيّة لحركةٍ إسلامية تحاول إخراج نفسها من الشّوَه الذي تسببت به التجربة المصرية على بقيّة الحركات، وللالتفاف على الوعي الشعبي العربي، ولمجتمعاتٍ يعرف أبناؤها الجريمة المترتبة على التعاطف مع مثل هذه الحركات.
يعيدنا هذا الجدل في التحليل، والاستعجال في «إعلان نهاية الإسلام السياسي»، لأطروحةٍ كتبت عام 1995 لآصف بيات حول: «قدوم المجتمع ما بعد الإسلاموي»، معلنًا اكتشافه لاتجاه صاعد داخل التيار الإسلامي، شرح هذا المصطلح بكتابٍ مشترك «ما بعد الإسلامويّة» (صدر في فبراير/ شباط 2016) يحذّر من تفسير «ما بعد الإسلاموي» على أنها مقولة «انتهاء مرحلة تاريخية، وبداية مرحلة جديدة. وبغضّ النظر عن الدلالة التحليلية لـ«ما بعد»، لا يمكننا التغاضي عن المكوّن التاريخي لتجربة ما بعد الإسلاموية، إذ إن هذا يأخذنا إلى أرض الذاتية المنزلقة، بمعنى ما: «تعمل ما بعد الإسلامويّة أساسًا كبناء نظري للإشارة إلى التغيّر والاختلاف، وجذور التغيير، ولا يعني بزوغ ما بعد الإسلاموّية بالضرورة النهاية التاريخية للإسلامويّة، فما تعنيه هي ولادة خطاب وممارسة مغايرة كيفيًا، نتيجة الخبرة الإسلامويّة». لكنه يعود إلى منزلقٍ نظري فظيع، حيث اتجه لقراءة «ما بعد الإسلامويّة» لدى حزب الله: «في أفضل الأحوال، قد يمثّل حزب الله شكلاً من ما بعد الإسلامويّة المتوجهة نحو الممارسة والفعل أكثر من البلاغة الخطابية، ونحو تحوّلٍ في السياسة تدفع به تعقيدات المجتمع اللبناني وتاريخه، في الوقت الذي تخلّى فيه الحزب عن فكرة إقامة دولةٍ إسلامية باختياره العمل داخل الدولة المتعددة الديانات والأعراق، وحاول حسن نصر الله معالجة هذه الثنائية بالتمييز بين الفكر السياسي والبرنامج السياسي»!
ثم ينبهر بجوابٍ أعطاه إياه محمد حسين فضل الله عام 2004، منكرًا أن يكون النموذج المأمول هو نموذج «ولاية الفقيه»!
مبدئيًا فضل الله لم يكن له دالّة على الحزب، على الأقل في العقدين الأخيرين من حياته، وعطفًا على تصوّر الدولة الإسلامية لديه نأخذ هذا النص له: «إننا نقول للمسيحيين في لبنان، وفي غير لبنان، ادرسوا التاريخ، فإن التاريخ الذي حمى المسيحية واليهودية في داخل الدولة الإسلامية هو دليل على أنه من الممكن للمستقبل الإسلامي أن يحميها بشكل أكبر، كما أن الإسلاميين عندما يطلقون المسألة الإسلامية للجمهورية الإسلامية في أي مكان فإنهم ينطلقون من الخط القرآني الذي يعترف بأهل الكتاب، ويدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء ولا يلغيهم» (من كتابه في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي، ص67، من مطبوعات دار الملاك، 1998).
هذا المنزلق من آصف بيات الواضح، حول حزب الله وفضل الله، يشبه كثيرًا التحليلات التي ارتبطت بتصريحات راشد الغنوشي حول موضوع ترك جماعة الإخوان، فالقصّة في الوعي الأكاديمي بموضوع تلك الجماعات، مثل آصف بيات الذي ينكر رغبة حزب الله بإقامة دولة إسلامية، بينما هذا مثبت كتابةً وصورةً.
بهذا نتبيّن كون عموم التصريحات والمراوغات مجّرد تغييرات على العناوين، وتجديد في الشعارات لتحسين شروط الحضور في المجال العام، ولغرض تجاوز المحظور الاجتماعي والقانوني الضاغط والرابض على صدور الحركة الإسلامية بالعالم، هناك نزوع نحو إدانة تلك الحركات وتحميلها للدمار والدماء والأشلاء، وبحوث جادة رصدت التأسيس النظري الذي سببته جماعة الإخوان المسلمين لتكون مرجع تنظيمات «القاعدة» و«داعش»، هذا سبب الهروب اللغوي واللفظي لديهم.. ولتعلمنّ نبأه بعد حين.
مايو
18
حول «النسكيّة البروتستانتية».. و«التطهّرية النجدية»
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 12 مايو 2016
سخونة كبيرة تبعت الإجراءات الهيكلية بالحكومة السعودية، اشتعل النقاش عن حال المجتمع، والمنعطف الذي ستفرضه عليه الدروب الاقتصادية المتعددة، ستغيّر طوعًا أو كرهًا من قيمه، وثقافته وإيقاع وجوده وحياته. قد يهدّم الاقتصاد ما عجزت عنه كل رؤى المثقفين اللاهثين وراء المجتمع بسياطهم وألسنتهم وكتبهم ومقالاتهم طوال نصف قرن، مناقشين أثر الطفرات على القيم، وتدمير النفط لأنماط الإنتاج، وحراسة التعليم للنماذج المهشّمة القائمة، وتربية الاقتصاد الريعي لرؤى الاضطراب عن الحياة ومناكفة الدنيا. تغيير اقتصادي يُطمح أن يؤثر على الاضطراب الدنيوي، وينزع عن المجتمع الأوزار والأغلال التي كانت عليه. سيرة المجتمع الحديثة قد تشهد صفحاتٍ أخرى بسبب تجديد معنى العمل، والثقافة المرتبطة بالمال والثروة، والأسس التي بنيت عليها الرؤية والهيكلة، وتغيير الإرث المتراكم حول الآخر.
شكّلت التجارة في المجتمع السعودي، وقيم العمل أساسًا للبقاء على أرضٍ قاحلة، أصناف من المهن، وأسفار عرفت بـ«العقيلات»، ارتباط بالدكاكين وقيم الريف، صحب ذلك انكفاء عن العالم وعفاريته وأسحاره، مع مسحةٍ نُسكية في العلاقة بالمال، وتأويل ديني لطفرات الدنيا، بما يشبه دور الأخلاق (البيروتانية: التطهّرية، البروتستانتية) حيث العلاقة بين الاصطفاء الديني والنجاحات المادية، كما في تحليل فيبر حول الأخلاق البروتستانتية في روح الرأسمالية. فعلى النقيض من الكاثوليكية، تكوّنت بروتستانتية تطهّرية (دين – دنيوي) مستعينةً بتعاليم كالفن وتسفنغلي وبولينغر. يعلّق فيليب راينو بأن أوروبا بـ«انتهاجها منهجًا عقلانيًا وبتطبيقها للتقنيات الحديثة المتوصل إليها انفتحت على الآخر، انفتاحا على العالم ساعدت الرأسمالية على الذهاب قدمًا في البحث عن أهداف أبعد مما تستطيع أوروبا نفسها أن تمنحه للرأسمالية المتوسعة».
بينما من أجل فهم العلاقات القائمة بين الأفكار الدينية الأساسية لدى البروتستانتية النّسكية والقواعد المستخدمة في الحياة الاقتصادية نستعيد مقارنين ولائذين بأطروحة فيبر حيث التحليل لكتاباتٍ متحدّرة من الكتابات اللاهوتية للقساوسة، تأخذ التطهّرية رأيًا في «الثروة» تطهّرية نسكية رأت أن أتباعها قادرون على خلق مؤسساتٍ حرة، وتبيح للدولة أن تكون قوة عالمية، لتحوّل من بعد روح المحاسبة لا إلى وسيلةٍ اقتصادية بل إلى مبدأ سلوكي عام، وفي الأدبيات البروتستانتية فإن مما يضرّ بالعمل تبديد الوقت: «أكبر الخطايا»، فحياتنا ليست إلا لحظة قصيرة جدًا وجميلة، ويجب ألا ننصاع لثرثرات غير مجدية، فالوقت هو المال، ليكون من بعد «العمل» وسيلة نسكية، وهذا – بحسب رأي فيبر – ضمن تنويه الكنيسة الغربية، يتعارض مع الشرق، بل مع جميع الأنظمة الرهبنية في العالم.
تأخذ حالة تربية الثروة، ومن ثم العمل على استثمارها بوصفها الخير من الله طابعًا نسكيًا، وعدم الانغماس في مباهجها، أو التفريط في نعمتها قيمة مشتركة لدى النسّاك والطهرانيين، والنموذج الذي دبّجه ببراعة فيبر بأطروحته المعروفة لتكون ضمن أهم ما طرح في عصره فتح السؤال حول قيم العمل أيضًا ضمن تاريخ المجتمع السعودي وبخاصةٍ في نجد، إذ تعتبر السعي في الأرض والضرب فيها ومسابقة طيور الفجر للبحث عن الرزق، ضمن النسك المأجورة دينيًا المحمودة دنيويًا وهذا عزز من قيم العمل والإنتاج رغم شحّ الموارد الموجودة فيها آنذاك ولم تعزز من ساكنيها هذه الجغرافيا القاحلة إلا بعد الثورة المناخية بعد القرن الرابع عشر الميلادي، حيث المطر المرمم لما تمزّق من أرضٍ أكلت أبناءها بأمراضٍ وجوعٍ وعطش، لقد كان العمل هو حصن الكفاح في المنطقة القاحلة قبل النفط، وهو العنصر المحافظ على البقاء المقاوم للانقراض.
ثم إن التصوّر الطهري الذي يستمر فيبر في طرحه عن «النسكية والروح الرأسمالية» لم ينفصل عن الترسيمة الطهرية التي تتناول التأويل البراغماتي، فثمار العمل هي التي تحدد الغاية الربانية من تقسيم العمل، مستعيدًا المحتوى البروتستانتي لدى باكستر بأن تقسيم العمل يجعل من الممكن تطوير المهارة، وأن التخصص في العمل يؤدي إلى زيادة ونوعية الإنتاج وبالتالي خدمة المصلحة العامة والثروة المماثلة لثروة العدد الأكبر من الناس. ثمة شبه أساسي بين الأخلاق التقليدية العملية في نجد قديمًا وبين النسكية البروتستانتية حملت نماذج تطهّرية كثيرة تنظّف الثروة والذات من العمل، وبخاصةٍ إذا تذكّرنا مع فيبر أن: «الكنيسة البروتستانتية، التي تمارس تأثيرًا في الحياة الدنيا، تتعارض تعارضًا حادًا مع التمتع العفوي بالثروات، وتكبح الاستهلاك، لا سيما في مجال الأشياء الكمالية، وفي المقابل، يكمن مفعولها البسيكولوجي في تخليص الرغبة بالكسب من كوابت الأخلاق التقليدوية» تعليق باركلي: «إن الصراع ضد إغواءات الجسد والتبعية للثروات الخارجية لا يستهدف أبدًا الكسب العقلاني، بل استخدام الأملاك استخدامًا لا عقلانيًا»، فالعمل لدنياك كما العمل لآخرتك، شعار مؤثر في القرن الثامن عشر نفعيًا.
القيم الأصلية التقليدية عمليًا والمعروفة في المجتمع السعودي قبل النفط لم تعد قائمة، بقدر ما تبددت، وآية ذلك أن آخر العمليين المعاصرين من كهول تلك المرحلة لا يصدّق ما آلت إليه الصيغ الرعوية في تشويه المجتمع، كان يمكن استثمار تلك «التطهّرية النجدية» قبل آثار النفط ومفاعيله، الرؤية السعودية، وأوامر الملك المعيدة للهيكلة هي تصحيح لمسارٍ رعوي طال أمده، وانتفعت منه عائلات وأمم غير أنه لن يكون أفق المستقبل، والتذكير بزمنٍ مضى كان فيه الدكّان صنو المسجد يحتاج إلى جهد حكومات ودول، ولله في خلقه شؤون.
مايو
18
رؤية 2030.. السعودية ليست نفطاً
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 28 أبريل 2016
من يتجوّل في المجالس والدواوين في السعودية هذه الأيام، يرى الحيوية في أوجها، الروح الشابّة الوثّابة القافزة إلى المستقبل بشجاعة انعكست بإيجابيتها على الناس. حوار «بلومبيرغ»، ثم لقاء «العربية»، بالتزامن مع إطلاق «رؤية 2030»، أوضحت تلك الأحداث الثلاثة صورة الأمير محمد بن سلمان الذي عمل طوال الأشهر الماضية بصمت لإعداد خطّة طموحة، بغية اقتحام المستقبل. ثلاثة وثلاثون عنوانًا للمستقبل خطّها الأمير الشاب فاتحًا الحُلم للمجتمع، ورافعًا عنهم أوزار القلق، حتى لكأنه يضع أمامهم الخريطة التي ستسير عليها طموحاتهم وصولاً إليها خلال عقد ونصف العقد! لكنها هذه المرّة ليست خطّةً عاجلة إسمنتية، بل رؤية لها روحها الاجتماعية، وضخّها الاقتصادي، وروافدها الثقافية والفنيّة والترفيهية.
سمع الناس من لسان الأمير ما يريدون قوله، واعتبروا رؤيته أفقًا لهم ينقذهم من أنفاق الوساوس والقلق من مستقبل يترنّح بين نفطٍ رخيص وناضب، وآمالٍ صعبة أو مستحيلة.
في أواخر القرن الماضي، انتشرت الطروحات الباحثة في نهايات كل شيء، المهووسة بالبحث عن الذروات، على المستويات الجغرافية والثقافية والسياسية والاقتصادية.. بحوث محمومة تريد أن تصل إلى مدى كل شيء، هوس القبض على جرم النهاية، ومآل كل طريق، وذروة كل منجزٍ آسر. وفي عام 2002، أصدر أحد أشهر علماء البترول المعاصرين الآيرلندي كولن كامبل، مع آخرين، أطروحة بعنوان: «نهاية عصر البترول»، وقد شغل المؤلف مناصب كثيرة بكبرى شركات البترول العالمية، واكتشف بنفسه كثيرًا من حقول البترول في أنحاء الأرض، وتحدّث عن أن «شروط الإنتاج ستنطوي، وقبل استخراج آخر قطرة بترول بفترةٍ طويلة، على مصاعب لا يُستهان بها». وهذه اللحظة من ذروة النفط، التي ستأتي يومًا لا محالة، كانت غصّةً في حلوق الباحثين في مجالات التنمية والنهضة، فبقدر ما ساهم النفط في تأسيس الأرض، وخدمة الناس، ورفع مستوى الطبابة والمعيشة والاقتصاد والتعليم، فإنه أثّر على القيم. ومن خلاله، يمكن الانطلاق إلى استراتيجية أخرى غير نفطية، فكانت «الرؤية». ولحسن الحظّ أن لحظة تغيّر قيمة النفط، أو انتهائه، لم تأتِ بعد، بينما استبقتها الرؤية لوضع حدٍ لمأساويةٍ اقتصادية يمكن أن تحدث ما لم نستعد لمثل ذلك الحدث الرهيب، بل الحدث الكابوس.
لقد تأسست السعودية من دون نفط، يقول الأمير، بمعنى أن النفط ليس دستورًا، وليس مقدّسًا. ومن هذه الرؤية، ينطلق في حديثه المرتّب لشرح الرؤية التي أقرّت من مجلس الوزراء، ويصرّ على ضرورة إقناع المجتمع: يحرص على جمع المغرّدين، والمثقفين، والدعاة، والمتخصصين، من أجل نقل الصورة لهم، لشرحها لمجتمعهم، فلديه رغبة ملحّة بالإقناع والإفهام، وهذا يذكّر بما فعله جدّه الملك عبد العزيز، إذ كان شغوفًا بإقناع من حوله بما يهمّ بفعله، وما يريده لمجتمعه، كما يروي مستشاره حافظ وهبة. والأمير امتلك خاصّية الإقناع، حين تحدّث بوضوح حتى عن الوزراء والأمراء بما يجب عليهم الالتزام به ضمن هذه الرؤية التاريخية، وفي حديثه عن الفساد وضرورة مكافحته ضمن عمل المؤسسة المخوّلة بذلك.
ورغم الزخم الاقتصادي الذي تضمنته الرؤية، والحديث عن مراحل ما بعد النفط، والبدء بترشيد الإنفاق، والتخطيط للصناعة العسكرية، غير أنها تضمنت التغيير الثقافي الاجتماعي، لجهة تمتين العلاقة بين المجتمع والفنون، فالمجتمع ليس نفطًا، والفنّ والترفيه له علاقة كبرى بحيوية الإنتاج. والاقتصاد أقصر الطرق للتغيير الثقافي والاجتماعي. قد تغيّر المعادلات الاقتصادية، والثورات المالية، ما لم تغيّره الرؤى والنظريات، والندوات والمؤتمرات، خاصة حين تكون محلّ اهتمام شخصي من الرجل الثالث في الدولة، صاحب الرؤية الوثّابة والشابة، مثل الأمير محمد بن سلمان. يمكن للاقتصاد أن يغيّر لا من قيم العمل والإنتاج فحسب، وإنما من الفضاء الثقافي والفكري والاجتماعي، ويمكنه رسم ملامح أخرى نحو الانفتاح على العالم، وتغيير القناعات الموروثة الغابرة.
مرّت عقودٌ من أحاديث العالم عن السعودية التي يسكنها الجيل الشاب بأغلبيةٍ ساحقةٍ، من دون أن يكون لهم أي صوتٍ أو تدبير، غير أن هذه المرحلة من التاريخ جعلت أميرًا شابًا يشاركهم آراءه ومقترحاته، ويرسم معهم رؤية البلاد، ويرى فيهم ثروةً لا تضاهى. في حواره يقول: «يجب أن نشيد بكل السعوديين، لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدًا ومشرفة، خاصة في جيل الشباب: طاقة قوية، شجاعة، ثقافة عالية، احترافية جيدة وقوية جدًا. باقٍ فقط العمل، نعمل لصناعة السعودية التي نريدها في المستقبل، لكن هذا لا يعني أننا نركز ونكثف في كيفية تثقيف وتعليم وتطوير أجيالنا القادمة، هذا عنصر مهم جدًا». إنها السعودية الجديدة، ولادة أخرى لمستقبلٍ آخر، اختار الملك سلمان من هذا الجيل الوزراء والمسؤولين وكبار التنفيذيين. وداعًا أيها النفط، ومرحبًا بمستقبلٍ آخر، يجمع بين المسؤولية والإنجاز والاستقرار والرفاه، فالخليج ليس نفطًا، كما قال يومًا الوزير الراحل غازي القصيبي.
مايو
18
ذكرى بغداد.. أفول الدولة وانقراض المجتمع
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 15 أبريل 2016
تمرّ الأيام لنستعيد بذكراها الكوارث. ذكرى الهجوم الأميركي على العراق 2003 مرّت في بحر هذا الشهر، وسط صورٍ صادمة للتحوّل المهول للحال قبل الغزو وبعده، وأبرز دليل على ذلك الانهيار الشامل وفقدان كل ما يتعلق بمفهوم الدولة لصالح جمع من الكيانات المعزولة أو الدويلات، بينما تحدّث الرئيس الأميركي أوباما عن أخطائه في ليبيا، حيث تدخّل ولكنه لم يوجد أفقًا سياسيًا، وقبل أيام كشفت جريدة «الشرق الأوسط» عن اتصالاتٍ بين موظّفين في مطار بيروت وجماعة إرهابية.. هذه الدول بمجموعها تعبّر عن السقوط المدوّي لدولٍ عربية في براثن الحالة الميليشياوية التي تؤسس الدويلات المتجاورة المتناحرة، سمتها السلاح، والإغارة والقتل، وتقاسم التركات، وتأجيل أمد الأزمات، وإنكار قيمة الفرد، وتشويه معنى الإنسان.
والمجتمع الذي تديره الدويلة يتحوّل إلى جمعٍ من المأجورين المسامرين، وتعود الحالة الاجتماعية إلى حال «ما قبل الطبيعة»، إذ لا قانون يحاسب، ولا مؤسسات تنظّم، ولا تعاقدات تحترم.
تعبّر الدول الفاشلة تلك، التي سرّع بفشلها إما الغزو، أو الثورة، عن القلق العميق الذي يشعر به الباحث حول طبيعة العلاقة بين المجتمع والقانون، وهذا يذكّرنا بالدراسات الراصدة لتلك العلاقة في مراحل ما بعد الاستعمار، أضرب مثلاً بأعمال هائلة لنجيب بودربالة الذي ساهم مع أستاذه بول باسكون في إرساء اللبنات الأولى لسوسيولوجية القانون لمرحلة ما بعد الاستقلال بالمغرب، ويدور مشروعه حول علاقة القانون بالمجتمع، وعلاقة الأنظمة العقارية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى القانون القروي، وحقوق الإنسان، والنظام الغابوي، وقد عمل مع أساتذةٍ كبار في فلك الدراسة الاجتماعية الفذّة في المغرب مثل عبد الله حمّودي (صاحب أطروحة الأضحية) ومحمد علاوي وعبد الله حرزني، بمشاركة عبد الكبير الخطيبي.
الدراسة المجتمعيّة لمجتمعات ما بعد الاستعمار، لم تعضد بما يماثلها لمرحلة ما بعد الحرب على العراق، أو لمرحلة ما بعد «الثورات». تلك الدراسات المغاربية بكل معنى الكلمة هي إسهامات جليلة، يمكن الاستفادة منها بنقطةٍ أساسية تطرّق إليها أستاذ الإنثروبولوجيا بجامعة بريستون عبد الله حمودي، الذي استنكر التفاسير ذات البعد «الحتمي» عبر استعادة حتمية التحليل النفسي، أو البنيوي، المتجاوبة مع الآفاق الثورية عبر حسم تفسير المجتمع من أجل إيجاد بديلٍ حاسمٍ أيضًا، ويأتي ضمن هذا حال «حتمية التحليل السياسي» المنتشرة حاليًا، التي تعبّر عن قطعية في فهم المجتمعات وتحوّلاتها، وإسراعٍ نظري لإيجاد البديل المسوَّغ تحليليًا تجاه هذا المجتمع أو ذاك.
كل أفولٍ للدولة يصحبه انهيار في شبكة العلاقات بين أفراد المجتمع، وبين المجتمع كله والقانون، وانعدام إمكان التعويل على إبرام أي تعاقدٍ مدني مزمع بين أي فردٍ وآخر، وبين أي مؤسسةٍ وأخرى، لتكون الحال الطبيعية الأولى، حالة ما قبل المجتمع، بكل وحشيتها وحيوانيتها وغابيتها هي الشرعة والحَكَم، ويعيدنا هذا إلى ربط هيغل في «مبادئ فلسفة الحق»، إذ يرى أن «المجتمع المدني، هو دولة الضرورة والفهم، فهو يتطابق مع لحظة الذاتية، في مجمل فلسفة الحق، وفيه يعتقد الأفراد أنهم يحققون حرياتهم الفردية والذاتية. إن الدولة الحقيقية التي أعضاؤها مواطنون واعون بأن إدارة وحدة الكل ترتفع فوق المجتمع المدني، ما دام أن الدولة هي واقع الإرادة الجوهرية، واقع تتلقاه في وعيها لذاتها الذي أصبح كليًّا، إنها العقل في ذاته ولذاته، وهذه الوحدة الجوهرية هي غاية خاصة ومطلقة وثابتة، تحصل الحرية منها على قيمتها العليا».
مجتمع الدولة الفاشلة أفراده دومًا في كل لحظةٍ في حالة حربٍ مستمرة، حتى لو لم يملك بعضهم السلاح، هناك شراهة للاقتسام، أنياب ومخالب مجهّزة للانقضاض، أحقاد مرعيّة تُحرس من قبل الدويلة الصغيرة ضد الدويلة الصغيرة الأخرى، ومهما كان حال المجتمع ثقافيًا أو مستوى تطوّره وإرثه المدني تاريخيًا، غير أن إمكان الحرب واحتمال القتل هو الأساس ساعة أفول الدولة، حدث هذا في حروبٍ أهليّة أوروبية، نستشهد بفيلسوفٍ أرّخ الحرب الأهليّة البريطانية «توماس هوبز»: «ما دام أن وضعية الإنسان في حالة الطبيعة هي (حالة حرب الكل ضد الكل)، وهي حالة يحتكم فيها كل واحدٍ إلى ما تمليه عليه ميوله وأهواؤه، ولأنه لا يوجد ما يمنعه من استعمال كل ما يراه كافيًا للحفاظ على حياته ضد الأعداء، ينجم على هذه الحالة أن لكل إنسان الحق في كل شيء، بل إنه يملك الحقّ على أجساد أناسٍ آخرين، ولهذا فإن استمرار الحق الطبيعي لكل إنسان على أي شيء، لا يمكن معه لأي واحدٍ مهما بلغ من القوة والحكمة، أن يعيش المدّة التي تسمح بها الطبيعة للبشر عادةً».
حال الحرب هذه، والفوضى، وتحكّم الأكثر وحشيةً ببقية المجتمع نراه في لبنان، وسوريا، وليبيا، وسواها من عشرات الدول الأخرى، إنه حال صعود الدويلة وأفول الدولة، حيث يسهل بقر البطون، وقطع الرؤوس، واستباحة الدماء، وإخلاء البيوت، وغزو المدن بالسيارات ومجنزرات الميليشيات، هنا تكون المجتمعات في حالةٍ تستعد معها إما للموت، أو للانقراض والتلاشي، تنقرض جغرافيًا وتاريخيًا ما لم يكن هناك مشروع لإنقاذ الأرض والناس من وباء الحرب الأهلية الممكنة أو القائمة. حتى السلام بين الطوائف أو القبائل أو الفصائل لا يعبّر عن تشكّل الدولة، فعلى سبيل المثال المرحلة اللبنانية كلها التي تلت اتفاق الطائف ليست إلا «هدنة» أعقبتها مناوشات وحروب، إنها هدنة مطوّلة لأن مفهوم الدولة لم يتشكّل هناك.
«وليم ييتس» الشاعر الإنجليزي، عاصر حربًا أهليّة بآيرلندا عام 1916، فوضى خلّفت المجازر، قتل فيها الكثير من أصدقائه، حينها كتَب: «لا شيء عدا الفوضى يروم العالم.. وهيبة البراءة غريقة في كل مكان».
مايو
18
الكهوف والحتوف.. من كابل إلى بروكسل
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 31 مارس 2016
تداولت وسائل الإعلام صور مظاهراتٍ في أوروبا تشجّع اتجاهات اليمين وتياراته، فأوروبا بحالة حرب، والضرب وصل إلى القطارات والمطارات، العمليّات المتتالية والتهديدات المتزامنة في أوروبا قلبت جميع الصيغ، وأعادت تدوير الأوراق، إنها بداية لمرحلة أخرى تتعلق بمواقع الهويّات، وأسس التعايش، وأنماط الاندماج. بلجيكا التي تمثّل طوال تاريخها موقع التمازج العرقي وتنوّع الأصول ضربت بمقتل، وآية ذلك أنها البلد الأكثر إيواء للاجئين من شمال أفريقيا وتركيا، إنصاف دستوري للمسلمين، شعائر تقام، تسهيلات كبرى وضعت بالقانون لجميع المسلمين، غير أنها ارتدّت على قلب أمن الدولة القومي الذي يمثّل علامة التنوّع الأوروبي، ويؤوي مؤسسات أوروبا الكبرى كالاتحاد، وحلف الناتو.
منذ منتصف التسعينات والحشود الأصوليّة المنظّمة الهاربة من بلدانها تغرس جذورها في بلجيكا، ما تبقى من جبهة الإنقاذ، والعائدين من مواقع القتال في أفغانستان بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، والمتدرّبين في البوسنة، والمطاردين من بلدانهم واللائذين بقانونٍ رحب. بعد الحرب الأميركية على العراق 2003، أصبح التحوّل الذي يريده تنظيم القاعدة يتجلى بالهيمنة على التنظيمات المقاتلة في المغرب العربي، فاستطاعت «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» أن تعيد نسج الخيوط لإيجاد بذرة الثقة مع تنظيم القاعدة، بعد سوء الفهم الذي شاب علاقة أسامة بن لادن مع «الجماعة الإسلامية المسلحة» إبّان إقامته في الخرطوم، وتحديدًا في منتصف عام 1994، بعد رفض أمير الجماعة جمال زيتوني أن يشارك في الحرب ضد النظام الجزائري. كان زيتوني حينها قد جنّد ثلاثة آلاف مقاتل، وهو ما أخذه بن لادن بالحسبان، بسبب عجزه هو عن حشد ما يقارب العدد لتنظيم القاعدة في ذلك الوقت، بعد انصياع الجماعة لتنظيم القاعدة في صيف عام 1998، أمر بن لادن بتغيير اسمها إلى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» وبدأ الاندماج بمفاوضات معروفة بين حسان حطاب وأيمن الظواهري.
انتعاش تنظيم القاعدة في دول المغرب مرّ عبر التعاون في العراق، وفي الشيشان عبر «الجزائريين الأفغان»، شكّل التقارب المتصاعد أساسًا بني عليه إعلان 2003 ببيان المساندة الذي جمع بموجبه التنظيمات المتعددة تحت اسم «تنظيم القاعدة في المغرب العربي». كل تلك المروحة الأصولية التي دارت منذ منتصف التسعينات، وإلى العام 2009، تغلغلت في أوروبا ونفذت عبر التلاقي الاستراتيجي والجغرافي بين المسلمين المغاربة وبلجيكا، بالإضافة إلى وجود البيئات الحاضنة، والنواة المواتية لوضع خلايا صغيرة تقوم بأعمالٍ نوعية تنطلق من بلجيكا إلى مناطق أخرى من العالم، كما في خليّة «طارق معروفي» التي نفّذت اغتيال أحمد شاه مسعود في التاسع من سبتمبر (أيلول) عام 2001 ضمن خطة محكمة. نفذ الاغتيال بواسطة خريج معهد الصحافة بتونس عبد الستار دحمان، والمصور الصحافي رشيد بورواي.
بعد طي خليّة طارق معروفي، بقيت الجذور تتمدد ببطء ورويّة، لم تكن بعدُ بلجيكا موضوع استهداف، بقدر ما استمرّت نقطة انطلاق، التغطية الاستراتيجية والجغرافية يؤمنها نفوذ تنظيم القاعدة الذي هيمن على التنظيمات المنافسة وأذابها في مصهرته، مما جعله ممسكًا بالمنافذ وراعيًا للطلبة المتعاطفين، وللجاليات ممن يرى فيها خلايا نائمة يستطيع استثمارها في لحظات الصفر. بعد الأزمة السورية باتت الصورة أقلّ ضبابية بالنسبة لأجهزة الأمن والاستخبارات، أرقام متضاربة عن أعداد البلجيكيين المنضوين إلى تنظيمات متعددة في سوريا، وبخاصة تنظيمي «داعش» وجبهة النصرة، الاشتراك من جهة، والعودة للمقاتلين من جانبٍ، عاملان ساهما في إعادة الحشد والتجنيد.
سير المنفّذين والمتورّطين في الجرائم، سواء في هجمات باريس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، أو هجمات بروكسل (22 مارس/ آذار 2016) كلها تشي بتوجّه عدمي آخر في المجال الإرهابي، ارتباط بالجريمة والمخدرات والجنس، ووصية تركها أحدهم معلنًا أنه: «لا يعلم ماذا يفعل» بينما موضع القضيّة صلاح عبد السلام، بحسب شهادة زوجة شقيقه، كان سارقًا أدمن الحشيش، وتعاطي الكحول. كذلك الأمر في المتورّطين في هجمات باريس فأحدهم كان يملك حانة. نقطة تحوّل أزّمت من العمل الأمني، وحشدت النقد ضد الاستخبارات البلجيكية، وجعلت من انتصار «داعش» في يوم بلجيكا الأسود، مهددا لبقية دول أوروبا، وربما سلك التهديد طريقه إلى الولايات المتحدة. بالتأكيد كان لتطوّر الحدث السوري، أثره على ترتيب الانتقام الإرهابي من بلجيكا، غير أن السيرة الكبرى لأيام بلجيكا السوداء، في صبيحة يومها الغائم، كانت تتويجًا لعقدين من الترتيب والصفقات بين التنظيمات المسلحة، الممتدة مساحتها من جبال أفغانستان والشيشان، مرورًا بالعراق وانتهاء بالتشكيل القاعدي الأضخم في المغرب، والذي التهم بالتدريج منذ 1995 وإلى 2003 التنظيمات الصغيرة، وجعلها في جبته.
القصّة لم تكتمل، ربما هي بداية الحرب كما تحدّث هولاند، قبل ستة عشر عامًا كان ما يجري في كابل يبدأ من بروكسل، والمعادلة الآن أخطر، فالتنظيمات أكثر قوّة وقدرة!
كان أحمد شاه مسعود في ليلته الأخيرة على موعدٍ مع صحافيين يتقنان الفرنسية، وأحدهما يجيد الإيطالية، بجوازاتٍ بلجيكية، لإجراء حوارٍ صحافي، سارا في منطقة فيض آباد، واستقلا طائرة ومنها إلى منطقة ولاية «تخار» ومن ثم إلى بلدة خواجه بهاء الدين، صديقه القديم مسعود خليلي يقرأ عليه كالمعتاد من شعر حافظ شيرازي، عادة قديمة، يفتح الديوان عشوائيًا، والنصّ الذي يُقر يعبّر عن نبوءة تمتم ببطء: ««تمتع بهذه الليلة التي سنمضيها معا لأن الأيام تمضي، والأشهر تجري، والسنين الكاملة تأتي، إلا أنك لن تستعيد أبدا هذه الليلة». بعد تسع ساعات كان دماغ أحمد شاه مسعود قد انتثر على سجّادته، البلجيكي العربي فجّر الكاميرا. هذا جزء من قصّة حربٍ بدأت الآن على أيامٍ من الدم السائل والسواد الكالح.
مايو
18
اللاجئون.. بين أحلام “رمضان” وواقعية “موران”!
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 17 مارس 2016
أحيت معضلة اللاجئين في أوروبا بأخبارها المتسارعة والمتجددة معظم الإشكاليات التي تربط المسلمين بالغرب. أيقظت أحاديث الهويّة والحرّية وموضوعات الدولة، وأشعلت النقاش المتضافر لدى الدوائر الأكاديمية والمجاميع البحثية. هناك فضول للحديث عن تلك النازلة الجديدة المفاجئة، إذ تتجذّر هويّة أخرى داخل الدول الأوروبية الكبرى ضمن سياقٍ إنساني ولكن يعقبه إشكال سياسي كبير. امتعاض من انتشار الأسماء العربيّة بين المواليد، ونقاش مستمر حاد، وآخر ذلك تلك المظاهرة التي شارك فيها نحو ثلاثة آلاف من النازيين الجدد واليمينيين المتطرفين في برلين احتجاجًا على سياسة حكومة المستشارة أنجيلا ميركل المنفتحة على اللاجئين، وكانت الشرطة تتوقع حضور بضع مئات من النازيين الجدد، إلا أنها فوجئت بحضور أكثر من ذلك بكثير… إنها النازلة الكبرى ذات التماسّ الفكري الاجتماعي السياسي، تفرض نفسها على التداول بكل المنصّات والمحافل.
يحضر اسم طارق رمضان لدى الإعلام الأوروبي بوصفه وجهة النظر الإسلامية «المعتدلة» لإشكالية اللجوء والاندماج وفهم الإسلام بين الكليّات والجزئيات وحلّ الاعتراضات المطروحة والسجالات التاريخية بين المسلمين والمسيحيين، وقد تحدثتُ عن ذلك في المقالة الماضية، غير أن كتابًا مهمًا صدر الأسبوع الماضي باللغة العربية إذ ترجم الحوار بين طارق رمضان وبين إدغار موران بعنوان: «خطورة الأفكار»، حوار مشوّق بين متكلّم فقيه ومتأمل في الأحكام الشرعية وبين فيلسوف صارم طالما تغنّى بالتصوف وتساءل في طيّات الدين.
اللافت أن ترجماتٍ أخرى لكتبٍ حول الإسلام صدرت بالعربية قبل أشهر قليلة مثل كتاب الصحافي الفرنسي آلان غريش «الإسلام، والجمهورية والعالم»، وكتاب أوليفيه روا «الإسلام والعلمانية»، غير أن أكثرهما راهنيّة وحداثة حوار رمضان وموران.
في الثلث الأخير من الكتاب يتحدّث طارق رمضان كالعادة ضمن التنويع الكلامي والدلالي، فهو ينكر مصطلح «الاندماج» بالنسبة إلى اللاجئين، مطالبًا بتجاوزه إلى مفهوم «التجذّر» بسبب كون التجذّر أكثر مناسبةً لأن الأجيال الشابّة – بحسب رمضان – أصبحت فرنسيةً تتحدث وتعيش بأنماط فرنسية. ثم يضيف: «إن مطالبة المسلمين للآخرين بأن يحترموا قيمهم وثقافتهم ودينهم وحتى ذاكرتهم يعتبر أمرًا مشروعًا، هذه المطالبة تعتبر حجة دامغة على هذا التجذّر التاريخي. فعندما يقوم الشباب بالصفير عند سماع النشيد الفرنسي الوطني أثناء مباراة كرة قدم ضد المنتخب الجزائري، فهم يقولون بالتأكيد بشكلٍ أرعن لكن بوضوح: إن الجزائر هي أصلنا وتاريخنا وذاكرتنا التي نفتخر بها، أما فرنسا فهي حاضرنا ووصمة عارنا، أما الصفير الذي نقوم به فهو لمناهضة العنصرية»!
بين حديث رمضان عن التجذّر ثم موضوع النشيد الفرنسي والعنصرية أسطر قليلة، آخرها نسف أولها، حين يكون هناك غصّة في عمق الهويّة المسلمة تجاه البلد الثاني، المفترض أن تكون هويّته هي البديلة والأكثر تجذّرًا ومديونيةً بوجه الخطابات المماثلة لما يطرحه رمضان بالنزعة الانكفائية، ولو أخذنا أمثلة الجيل الثاني من اللاجئين في فرنسا ممن لهم أصول عربية نرى المنضوين في الهويّة الفرنسية الفاهمين للدولة ومعناها المنخرطين في نظام العلمنة هم الأقدر على شكر بلادهم الأصلية بعقلانيةٍ مع إيمانٍ بالقيم الفرنسية كما تكشف ذلك حوارات مع قائد منتخب فرنسا السابق زين الدين زيدان، بينما طارق رمضان حتى الآن يتحدّث عن إرث تاريخي وإمكان تمييز عنصري، واستباق الاندماج بإحياء الجذر القديم في نفس النصّ الذي يتحدث فيه عن «التجذّر» بوصفه بديلاً عن «الاندماج».
يردّ إدغار موران على رمضان بأن «المكوّن القوي جدًا يبقى مرتبطًا في فترةٍ تاريخية غير محددة بشعورٍ عميقٍ بالظلم». الفكرة أن إدامة أنماط الظلم، وسكنى تاريخ الاستعمار، والتأمل الدائم الأبدي بقصص الهويّة بين أبناء الجيل الأول الحالي في أوروبا ممثلاً باللاجئين السوريين سيجعلهم يدخلون في تجارب صعبة وفاشلة على النحو الذي تمثله مآسي الضواحي والكيانات المنعزلة في أصقاع أوروبا. إن تهجير اللاجئين الحاليين تاريخيًا إلى التاريخ يصعّب من مهمة إدماجهم، هذا المعنى الذي يرفضه رمضان بحجّة أنه غير دالٍ على التقدّم الذي مثّله المسلمون في أوروبا، إذ وصلوا إلى حالة «التجذّر» في بلدانهم، ضاربًا المثال بتجربة العرب في فرنسا وخصوصًا الجيلين الثاني والثالث.
ثمة ما هو أشمل من الاندماج وهو «التعليم»، فالجحافل اللاجئة آتية من بلدانٍ إسلامية وظيفة التعليم فيها «حراسة ما هو قائم بالذهن» بينما الحاجة الملحّة إدخال النظام التعليمي المعتمد على المساواة وعلم الأديان المقارن والحسّ النقدي وأعمال العقل هي أساس الخضّة التي يحتاج إليها اللاجئ، وهناك تجارب بدأت عبر ثانويات في ألمانيا للاجئين ضمن نمط تعليمٍ متجاوز للمعتاد والمكرّس الذي يحرس «الجهل المؤسس».
الحوار بين رمضان وإدغار موران عبارة عن كشف وسياحة بين جزيرتين، وبين عقلين، بين فضاء علمي معرفي مفهومي صارم ممثلاً بموران، وآخر لا يزال يطالب الدول الأوروبية بالاستفادة من «تطبيق الشريعة الإسلامية»، من هنا تأتي أهمية هذا العمل الحيوي والراهن.
إنها مأساة ملايين المنكوبين تسير بسرعة الضوء إلى المجهول! وقبل قرنٍ من الزمان كتب شاعر فرنسا الكبير بودلير: «وكيس نقود الفقراء وموطنهم القديم… إنه الرواق المفتوح على الآفاق… المجهولة».
مايو
18
جلبة خطابهم.. إذ شجّعت حظّ «اليمين»
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 3 مارس 2016
يعبّر طارق رمضان في القنوات الأوروبية باستمرار عن آرائه حول العلاقة بين المسلمين والغرب. أفكاره التي يطرحها تأخذ مسارًا شعبيًا بمعظمها، إذ يخاطب المسلمين بما يرغبون سماعه، لا بما يصدمهم، ويجب عليهم سماعه والتغيّر على أساسه. رمضان مغرم بالنتائج القطعية التي تكاد تكون كارثية من مثل إحالة نشوء تنظيم داعش مسؤولية ودعمًا على الغرب! طارق حفيد حسن البنا يعترف أن تسعين في المائة من وقته يقضيها للرد على وسائل الإعلام الغربية، بوصفها تفتري على الإسلام والمسلمين ولا تنصفهم. بآرائه وطروحاته تلك يعزز من نرجسية واهمة، بل ودَيْن للمسلمين على الغرب. وهو بهذا لا يصنع فرقًا بل يثبّت ما في الأذهان وما تغلغل المخيال. أخذ ذروة تماديه عندما تحدثّ عن كون الإسلام نفسه «الدين الأوروبي»، بينما هو من بين الأديان التي عاشت في أوروبا ضمن دياناتٍ أخرى.
ثمة خطاب قديم متحجّر لم يتطوّر منذ عقود، الخطاب الإسلامي في أوروبا لم يعد يخاطب مجموعة قليلة من العاملين والمبدعين، أو اللاجئين قسرًا، وإنما يواجه الآن زحفًا مهولاً من اللاجئين السوريين، يحملون ثقافة مختلفة، وخيالاً مناقضًا للذي ساد لدى المسلمين المستقرّين منذ نهاية عهود الاستعمار، وأنتجوا أجيالاً أكثر نضجًا من المسلمين المتشرّبين للثقافة الأوروبية وقيمها. تلك النبرة تساهم في تعزيز شرعية وحجج التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، خطابات المنّة أو ممارسة المركزية الثقافية على الحضارة الأوروبية وترسيخها بالخطابات الدينية والمناسبات التي تعقب العمليات الإرهابية. بعد أحداث باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، كانت التحديات أكبر من الخطابات المتحجّرة التي تلوك كلامًا يتحدّى مشاعر الأوروبيين بالمقابل يداعب وجدان المسلمين، ويعزز مصداقية أحزاب اليمين.
صوت طارق رمضان عبارة عن نموذج أدخل من خلاله لانتقاد مشابهين له آخرين، وإن كانوا أقل تأثيرًا وأضعف تعلّمًا، هم معه يعززون هذا النمط من نبرة الخطاب المتعالي وتشابه المقولات الطهرانية، من هنا تأتي أهمية دعوة مجموعة من المفكّرين العرب في فرنسا منذ أواسط الثمانينات بإنشاء كلية دينية في إطار «اتفاقية ستراسبورغ» من خلالها تعمل على تكوين أئمة يتمكنون من الجدل وتعدد التأويلات التي خلّفها التراث الديني المهمل في البلدان الإسلامية بغية مقاربة الظاهرة الدينية عن طريق فقه اللغة وعلم التاريخ والانثربولوجيا والتحليل النفسي والدراسات المقارنة. ورغم تأسيس أكثر من مجلس إسلامي في أوروبا لوضع التداول الإسلامي بشكلٍ مؤسسي فإن الغالبية من المسلمين لا يصدرون عنها، وحين تحدّث مسؤولون في ألمانيا وبريطانيا حول العمل على تبويب ثقافة إسلامية تستوعب القيم المعيشة في هذه الدولة أو تلك ثارت ثائرة البعض بوصف ذلك عدوانًا على الحريّة أو التعددية والتنوّع، بينما على العكس، مثل هذه الإجراءات تحد من تفاقم العدوان اليميني على المسلمين، إذ تندمج بالإضافة إلى الثقافة الإسلامية الأساسية حال من الوعي والتفاهم والانسجام مع الثقافة المختلفة في بلد السكنى أو اللجوء.
قمّة النرجسية المتعالية أن نتحدّث في وسائل الإعلام الأوروبية (كما فعل طارق رمضان) ونحمّل تلك الدول مسؤولية ظهور «داعش» مثلاً بينما تتحدّث بعض الأرقام عن أن واحدًا من أصل خمسة فرنسيين يمثّلون قاعدة ناخبي الحزب اليميني العنصري (الجبهة الوطنية)! بالمقابل ليس المطلوب من المسلمين تحمّل الإدانات والنبز والتمييز، وإنما حذو التجارب الناجحة للأمم والديانات والأعراق الأخرى، وبخاصة في ظل هذا الموج من اللاجئين في ألمانيا تحديدًا وبقية الدول الأوروبية الأخرى، وأبرز تلك الأسس استيعاب القيم الأوروبية وحريّة التعبير وتحمّل النقد في المسرحيات والصحف ووسائل الإعلام.
تراوغ بعض الخطابات المنتمية للمسلمين هناك حين الحديث عن «الهويّة» بوصفها منغلقة مصمتة، ولهذا يؤسسون كيانات منعزلة، وينكفئون عن المجتمع، ويضربون عن تعلم لغة البلد المقصود، وهذه أخطر صياغة للهوية، وهي الكفيلة بتحويل التجمعات الإسلامية إلى مشاريع خلايا إرهابية أصولية كما حدث في فرنسا قبل أشهر قليلة، عبر تحالفٍ استثنائي بين كيانات مغلقة على أسس الهوية في بلجيكا مستثمرة سيل اللاجئين المسلمين في ضواحي باريس وسواها، من هنا جاءت صرخات الساسة بضرورة فهم ثقافة البلد المقصود والإجبار على تعلّم اللغة، هناك ضوابط وقوانين على اللاجئين هناك، هي ليست ضدهم على الإطلاق وإنما توضع لمستقبلهم ودمجهم وإفادتهم وإزالة غربتهم ووحشتهم، ما يزرع الغربة والوحشة والكراهية هو جدر «الهويّة» الواهمة المدمّرة.
ليس سرًا أن اليمين المتطرف في أفضل حالات انتعاشه حاليًا، بسبب من استفزاز الطوفان الآتي، وتغلغل التنظيمات المتطرفة، ووحشية العمليات الإرهابية، هذا بالإضافة لكون المسلمين لم يحددوا بعد دنيوية واقعهم وأصالة براءة الآخرين الذاتية، هذا الاضطراب في فهم موقع الدنيا أسس لموجاتٍ من الاضطراب في العلاقة مع الغرب، ولعل مثال الدكتور طارق رمضان غاية في الوضوح، بوصفه متعلّمًا وفصيحًا غير أن النتائج التي يطرحها والمقولات التي يدوّرها على الشاشات الفضائية لم تخدم المسلمين بشيء، بل في غالبها تخاطب وجدانهم وتطمئنهم على صواب الانغلاق والانكفاء، وتخدم تلك المقولات اليمين المتطرف.
الحقيقة متوزّعة أمامك، خارج أنفاق هويّتك، إنها في الآفاق من حولك، وقديمًا كتب «غوته» – ديوان الألمان الشغوف بالشعر العربي -: «ليس بالضرورة دائمًا أن يتخذ الحق جسمًا، يكفي أن يحوم في الضواحي كروحٍ، ويحدث نوعًا من التوافق مثلما تفعل الأجراس حينما يطوف رنينها في الجوّ، حاملاً السلام».
مايو
18
مأساوية التقنية.. بين شايغان وفريدمان
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 16 فبراير 2016
تبني التقنية بوحشيتها الحالية وفراغها الأصيل هياكل للانحطاط والانهيار. الوحشيّة التي استخدمت بها على كل المستويات تضعها باستمرار أمام المساءلة واللوم. يتساءل توماس فريدمان في مقالته قبل أيام: «هل مواقع التواصل الاجتماعي مخرّبة أم بناءة؟ هل اتضح أن مواقع التواصل الاجتماعي نجحت فقط في تحطيم الأشياء لا بنائها؟». أسئلة يطرحها فريدمان، وكأنه يكتشف إشكالاً جديدًا، بينما منذ أن بدأت هذه الثورة التقنية الجارفة وهي فارغة، ملأتها المجتمعات العربية والمسلمة بأصنافٍ من الانهيار الأخلاقي، والتشّوه اللفظي، والصراع الطائفي، والمكابرة القبليّة، وكل ما يعزز من الاستئصال والقتل، ووجدت التنظيمات الإرهابية في التطبيقات ملاذًا آمنًا للتجنيد والحشد، والتكفير وبثّ فيديوهات القتل والاغتيال. لم تكن التقنية إلا التعبير الأمين عن ورطةٍ نظرًا لسحرها، وسهولتها، وإتاحتها، وعدم تطلّبها أي قيمٍ مصاحبةٍ تفرض نفسها على المستخدمين، بل أطلقت مثل ماردٍ اجتاح المدينة على حين غفلة.
ربما هي حال من «التغريب اللاواعي» بحسب داريوش شايغان، حيث تفرض على المرء حالة من الاستهلاك والصيرورة لا حول له ولا قوة إزاءها، وإنما يكون سابحًا مثل غيره في موجةٍ لا يعرف مكانها ولا زمانها، على الضفّة الأخرى فإن «التغريب الواعي» يرتبط بقيم «الغربنة» الأساسية المصاحبة لمنتجيها وخالقيها. عبد الوهاب المؤدب في كتابه: «أوهام الإسلام السياسي» فرّق بين نزعتين شغّالتين وحيّتين في قلب صيرورة التغريب بين «الأورَبة» و«الأمركة» إذ: «تقترح الأمركة عليك التقنية من دون أن تفرض عليك أن تغيّر ما بنفسك، فيمكنك البقاء على ما أنت عليه، وتتمتع بكل ما توفره لك التقنية، ربما كان هذا أحد مفعولات تعميم التعددية الثقافية على صعيد كوكب الأرض، ومثل هذه التصرفات تتناسب مع ازدهار الراديكاليين.. في مرحلة الأوربة كان يبدو لنا أنه من الضروري أن نعمد إلى تحويل قيمنا إذا ما أردنا التمتع بكل ما يوفّره لنا القرن.. في تونس في الخمسينات كانت الخصوصية الفرنسية فعّالة لقد كنا متأكدين من أننا أمام عالمية جديدة، في المدرسة كنا نتعلم كل المبادئ النابعة من ثورة 1789».
ارتبط التحديث التاريخي بالقيم المنبثقة من المنابع الأساسية حينها، لأجل ذلك حصل تعميم التعليم العلماني على يد أناسٍ تشبّعوا بالقيم الفرنسية والقانون الفرنسي، لغرض تأسيس معنى الدولة ضمن قيمٍ حديثةٍ من دون الفصل بين الحالة التحديثية والقيم المصاحبة التي على المجتمع تحويل قيمه على أساسها، في هذه اللحظة بين الاستقبال اللاواعي للمنتج الغربي السياسي والتقني الأداتي وبين الغربنة الواعية متمثّلةً باستيعاب القيم الحديثة، بالإضافة إلى منتجات الحداثة يكون الفارق الصارخ بين الأوربة والأمركة. إن تفريغ التقنية وفصلها عن قيم منتجيها حوّلها إلى مرآة تشبه مستخدميها من أسامة بن لادن إلى أبي بكر البغدادي والظواهري، وجيوش المستخدمين المغتبطين بجهلهم والمخدوعين بتأثيرهم، والمبذّرين لأوقاتهم على أجهزتهم السارقة لوجودهم الحي، حيث لا قيمة للمكان ولا الزمان.
سبّبت التقنية بثورتها العاصفة بمرضٍ تنبأ به هيدغر إنه «وهن الكائن» تكون العدمّية فيها من خلال تحشّد الوجود الحديث وتغطيته الإعلامية كما دنيَوته واستئصاله لإبراز الاستلاب، والانتزاع نحو مجتمع التنظيم الكلّي. بينما «فاتيمو» في إعلانه: «نهاية الحداثة» يكتب بلغة النعي: «إن سماع نداء جوهر التقنية لا يعني الاستسلام من دون تحفظاتٍ على قوانينها وألاعيبها، ولذلك يصرّ هيدغر بحسب ظنّي، على أن جوهر التقنية ليس بتقني، ومن هذا الجوهر يجب أن نحترس»، ثم يشير إلى خطورة ممارسة التقنية لـ«بنية الاصطناع المفروض».
من الضروري الاستمرار بهجاء التقنية بوصفها ذروة ورطات التحديث، وكرة النار التي قذفت على خيم المجتمعات الحائرة أصلاً في وجودها، الخائفة من غدها. ورطة التقنية تجاوزت انعدام قدرتها الوظيفية على تحويل القيم في المجتمع الذي تهبط عليه، لتكوّن وتنتج «قيم انحطاط» مكررةً إنتاج ما التاثت به المجتمعات أصلاً من ممارسات العنف الشخصي والرمزي، أو التناحر العرقي والطائفي، أو السباب السوقي. حتى وإن كانت التقنية لا تفكّر، بمعنى أنها حالة أداتية إلا أنها نتاج تاريخ من الطفرات المنجزة حدثيًا، استطاعت تفتيت الحدود، وتقريب المسافات، وتسهيل الاتصال، لكنها لم تفد في تقريب الثقافات وتفتيت الخوف بين المجتمعات، ولم ينجح الاتصال في تأسيس «تواصل» بالمعنى النظري للحوار العمومي كما لدى طارحها هابرماس.
يقظة فريدمان المتأخرة حول مواقع التواصل الاجتماعي، تأتي ضمن قلقٍ أكبر، حيث منع آلاف الحسابات في شتّى مواقع التواصل بسبب تبعيتها للتنظيمات الإرهابية، وقبل هذه الظاهرة كانت الظواهر الثوريّة للناشطين فيها من المطالبين بالتغيير الراديكالي للعروش والتمرد البدائي على الجيوش. التقنية ورطة كبرى، فهذه الأدوات الساحرة باتت عبئًا على مستخدميها الضائعين بين الإدمان المرَضي، والتهشّم الوجودي، والغرق حتى الأذن بالعته والجهل، والتيه في دروب أوهام التأثير والقوّة، بينما بالانقطاع عنها ومراقبتها من بعيد يفضح جذرها، إنها مجرّد سرابٍ بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.
مايو
18
تفاسير الإرهاب وأساطير العولمة
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 4 فبراير 2016

لم يهيمن الإرهاب وموضوعه على الواقع والحواجز، والأمن والحدود، بل دفع الدراسات الإنسانية بشتى تشعّباتها واهتماماتها من البحث عن مغامراتٍ متعددة، للبحث في جذور الإرهاب وألغازه.. عن مصادره ومنابعه، عن الطاقة التي ساعدتْه على البقاء طوال القرون التي عاشها المسلمون. أخذ الإرهاب والعنف حيويتهما من معاصرتهما، حيث استطاعا ركوب موجة المعاصرة والحداثة منذ ثلاثين سنة، ودخلا على خط التيارات اليسارية وجموع المقاومة وفصائل النضال متقاطعين معها في الأسلوب والهدف.
ومع خطاب «العولمة» والحديث عن «النهايات» بما فيها نهاية الجغرافيا، تصاعد التفسير السياسي للإرهاب، بحيث تحوّل إلى مظهر عولمي، وطفرة متوقّعة من نمط العولمة الكاسح الذي تحدّى الثقافات والهويّات واستفزها للنفرة والدفاع، ومن هذا التفسير حضر التعالق بين حلّ قضية فلسطين وانتهاء الإرهاب أوائل الألفية الحالية، غير أن أطروحة «الإرهاب – العولمة» كانت الأكثر ترددًا في صدى بعض الدراسات الفكرية حول العنف والإرهاب.
التفسير العولمي لموضوع الإرهاب كان مغريًا للإسلاميين بوصفه اختراقًا معرفيًا لتبرئة ساحتهم من الإدانة والمسؤولية، ولتحميل الغرب والإمبراطورية الأميركية عبء نشوء «القاعدة» بوصفها جريرة أفغانستان، و«حماس» لكونها نتيجة تعثّر موضوع فلسطين، وحزب الله لأنها حركة مقاومة تقوم بحماية المدنيين من نار إسرائيل.. هكذا يطرح تفسير الإرهاب في المواقع الإلكترونية الراديكالية منذ عشرين سنة وحتى اليوم. ويتقاطع مع هؤلاء بعض فلاسفةٍ ومفكرين غربيين، نأخذ مثلاً مقولة بول دوميشال، حين حذر من أنه لا يمكن فهم الإرهاب والعنف المهيمنين في الحاضر دون ربطهما بالعولمة، وأن الإرهاب يسعى إلى وضع النظام السياسي المهيمن موضع تساؤل، فهو مرتب بالإمبراطورية ومتواطئ معها، كما في المؤلف المشترك في كتاب «الإسلام والعولمة والإرهاب».
في الكتاب نفسه يطرح الفرنسي أوليفيه مونجان، رؤيته، حيث يذهب إلى أن الانطباع السائد بأن التهديدات الهوياتية والعولمة يؤديان إلى ظهور عنف داخلي مستشر يصعب التصدي له، سيعزز أطروحة «حرب الثقافات» التي فرضت نفسها بعد حرب الخليج، على العقول خلال سنوات التسعينات، وتؤكد فكرة أن مصدر التهديدات هو دائمًا مصدر خارجي. كل هذا الطرح حول التفسير العولمي للإرهاب لم تعد له قيمة أو جدوى، لأن كل الإحالات للإرهاب أو العنف بموضوعٍ خارج جوهرية مدده الفكري، مضيعة للوقت واستغلال للظاهرة بغية ممارسة التوبيخ الآيديولوجي، من خلال تعميم التحليل الاقتصادي والسياسي للموضوع الإرهابي، واستحضار الهوية، والنزاعات الأهلية، وحركات المقاومة، وقضايا التحرير العالقة في الشرق الأوسط وما سواه من العالم الثالث؛ إذ يعد أوليفيه روا هو الآخر أن الإرهاب بقدر ما هو حالة عولمة، فإنه بالأساس أيضًا «ظاهرة عالم ثالثيّة».
محمد أركون في محاضرةٍ له في بروكسل ألقاها في الخامس من مايو (أيار) عام 2007، بعنوان «الإسلام في مواجهة تحديات أوروبا الحداثة» ضرب على وتر العولمة في تحليل العنف، حيث قال بالنص: «إن العنف، على عكس ما يزعم الإعلام الغربي، ليس آتيًا فقط من جهة المتطرفين الأصوليين، وإنما من جهة الغرب وحلفائه أيضًا، وعنف العولمة الغربية هو الأقوى نظرًا للقوة الجبروتية للغرب». مع أنه مؤرخ استثنائي في تاريخ المسلمين الحديث من حيث الشجاعة في إدانة الطاقات المحروسة التي يستمد منها الإرهاب مدده، لكنه أراد ممارسة هوايته النقدية المفضلة في «الحرب على كل الجبهات»، وإلا فلا يمكن أن يعد أركون العولمة محرّكة الإرهاب وأساس العنف الديني، وإلا فإنه ينكر أبحاثه الكبرى وورشته في الإسلاميات التطبيقية التي بدأها منذ الستينات الميلادية.
على الضفّة الأخرى من السجال يدخل علي حرب في كتابه الصادر مؤخرًا «الإرهاب وصنّاعه» لإدانة التفسير العولمي للإرهاب، مصرّحًا بأنه يختلف «مع أوليفيه روا الذي يرى أن التنظيمات (الجهادية) هي (نتيجة العولمة) لا نتيجة الإسلام السياسي. مثل هذا الرأي يقوم على تناسي الأساس الفكري لـ(المشروع الجهادي)، وأن هذا المشروع هو الترجمة للفكرة الأصولية التي زرعتها في العقول الحركات الإسلامية». وهو بهذا يردّ على أوليفيه روا في كتابه «فشل تجربة الإسلام السياسي» في مقدّمته للطبعة الثانية الصادرة عام 1996.
مع ظهور تنظيم داعش، أعيدت نفس النبرات التحليلية تلك، عبر إحالاتٍ كثيرة. التفسير الإخواني لظهور «داعش» يتمحور حول «قمع الحكومات» للربيع العربي وتآمرها على انتخاب الإخوان المسلمين في تلك الدول، بينما يعدها البعض طفرة حداثية نتجت عن سيولة المعلومة وثورة التقنية، هذا مع تأكيد محللين آخرين على وضع «داعش» ضمن مؤامرةٍ غربية، وأخرى بعثية، ولا تنتهي التفاسير والإحالات لهذه الطفرة الدموية الاستثنائية.
بآخر المطاف، تبقى التنظيمات بما تطرحه من أفكار، ومن محاضرات وفتاوى، من كتبٍ مقررة، كل هذا النتاج يعبّر عنها أكثر من أي تفسيرٍ آخر، وإذا كان المتخصصون سيبقون لاهثين باحثين عن ألغازٍ مضمرة، وأسباب مبهمة، ووثائق استخباراتية سريّة لظهور التنظيمات، فإن المجتمعات الإسلامية التي فشلت في مواجهة تنظيمات سابقة، ستكون فاشلة أيضًا في مواجهة أي تنظيم لاحق. الإرهاب ليس سلاح الأقوياء كما يقول نعوم تشومسكي، بل الإرهاب سلاح المجرمين القتلة، وليس نتاج إمبراطورية أو جهة اقتصادية، بل نتاج ما بين الأيدي من التعاليم، إنها البضاعة المتاحة وقد أعيد ترتيبها بدمويّة فظيعة، ثم ارتدّت على المسلمين من جديد.
مايو
16
اللاجئون في أوروبا.. وأسئلة الإصلاح الديني
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 26 يناير 2016
من الواضح أن حضور الدين في المجال العام بشتّى الوسائل بات لافتًا بشكلٍ ندر مثيله، إذ غدا السجال حول الدين والتأويل ومشكل الفهم موضوعًا رئيسيًا، بالإضافة إلى الجماعات المتفجّرة بخلاياها المتنوّعة التي تمطر شرق العالم وغربه، مما يعيد التذكير بحاجتنا الملحّة لإصلاحاتٍ جذرية في المؤسسة الدينية بالعالم الإسلامي من جهة، وبحثٍ حثيث عن خطابٍ ديني معاصر يستطيع رسم خيارات التعايش مع المجتمعات من جهةٍ أخرى. زادت راهنيّة البحث في الخطاب الديني مع لوذ اللاجئين السوريين إلى أوروبا، حيث إمكانات الصراع وشرر النزاع كلها حاضرة. قبل أيام قرأنا عن مضاربةٍ في ألمانيا بين بعض اللاجئين بسبب مسألةٍ فقهية، بينما يحرص رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون على تشجيع وتهيئة خطاب ديني يصحح من مفاهيم اللاجئين للإسلام، ويدفعهم نحو قيمٍ لم يعرفوها من قبل وعلى رأسها موضوعات التسامح والاندماج والتعايش.
وسط كل ذلك الظلام الدامس في مجال الخطاب الديني ونقاشه وسجالاته اختار، أول من أمس، متحف الصحافة والإعلام «نيوزيام» في واشنطن منح «جائزة الحرية الدينية» للشيخ عبد الله بن بيه، وهو رئيس «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة». وهو فقيه مقاصدي ذو رؤيةٍ نقديّة لمناهج التأويل والاستنباط، وارتبطت فتواه بعللٍ مثل نقطة التقاء بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة وبين متطلّبات الحياة والعيش، هذا فضلاً عن نقده المستمرّ لمنهاجه هو في الدعوة والفتوى، إذ سرعان ما استقال من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وذلك بعد فورة الربيع العربي، إذ تبيّن له كما في تحليلاتٍ متعددة أن هذا التجمّع قاعدته الحزبيّة ترتبط تحديدًا بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، مع حرص هذا التجمع قدر الإمكان على ضرب المؤسسات الدينية في البلدان العربية التي تنضوي تحت العمل الرسمي، وذلك بغية استصدار فتاوى تساعد على الحراك الشعبي وتشجيع الثورات، واستباحة الدماء كما تنضح فتاواهم طوال السنوات الأربع الماضية، وهذا النقد الذاتي ساعده في رؤية الدنيا وأحكام عيشها ضمن مجالٍ أوسع من الإرث التاريخي المناسب لزمنه غير أن من المستحيل ترحيل أحكام زمنٍ مضى على زمننا الحاضر.
ثمة محاولات حثيثة للجم التطرف ووقف جموحه، ومخاوف كبرى من الانبعاث الأصولي في مناطق متعددة. هناك انتعاش لتنظيم داعش في شرق آسيا، وقبض على مجنّدين في سنغافورة تحديدًا، والنذير يصل إلى أستراليا، وكشف تفجير «جاكرتا» أن صراعاتٍ ناشبة بين قادة التنظيم هناك على الزعامة والتدبير، بين «بحرون نعيم» مخطط الهجوم، والأب الروحي للتنظيمات المتطرفة المسجون «أمان عبد الرحمن عبد القادر»، بينما يسعى التطرّف لخلافة النزاع الآيرلندي لدى أجهزة الأمن البريطانية كما في تقرير مهم نشرته رنيم حنّوش في هذه الجريدة في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي. وتتحدث المواقع الألمانية يوميًا عن «داعش» وخطرها ومآلات تخطيطها، تفاديًا لهجومٍ يتم ترتيبه من قبل خلايا «القاعدة» و«داعش» المعششة في منطقة «بولنبيك» في بلجيكا معقل التنظيمات المتطرفة في أوروبا ومنها خطط لتفجيرات باريس، ومنها خرجت خليّة طارق معروفي التي خططت لاغتيال أحمد شاه مسعود في 9 سبتمبر (أيلول) 2001.
مع نهاية القرن العشرين تحدّث أدونيس قائلاً: «كيف لخّص الإرهاب القرن العشرين»؟! وتساءل عن سبب انهيار قيم التعايش بين المسلمين، لدرجةٍ استحالت معها العودة إلى أسس التعايش القديمة الضاربة في تاريخنا الإسلامي وبخاصة في تاريخ الأندلس، وكذلك ساهم الأندلسيون في إنماء مناطق العرب والمسلمين حينها. هذا السؤال أرّق المفكّر المهم عبد الوهاب المؤدب في كتاباته الثريّة منذ «أوهام الإسلام السياسي» الصادر عام 2002 وركّز بشكلٍ جوهري على مسألة الدين وموضوعاته والأصولية وتحوّلاتها بعد الحادي عشر من سبتمبر، ومن آخر ما قرأتُ له كتاب «الإسلام الآن» تضمن حواراتٍ ثريّة أجراها «فيليب بتي» مع المؤدب قارن فيه باستقبال الأندلسيين في القرن الثالث عشر بعد سقوط قرطبة وأشبيلية ويتذكّر كيف: «عرفت مدينة ميلادي تونس وضواحيها في مدارٍ مساحته 70 كيلومترًا تلاقحًا حضاريًا يلمسه المرء في كل ما أتى به هذا النزوح الذي أغنى أنساق آداب التعامل الحضري، وكذلك الهندسة المعمارية، والصنائع والفلاحة والمصانع، إن مجيء الأندلسيين إلى عاصمةٍ أفريقية (تونس) نشر ثقافة الخلاسيّة التي يمكن للمرء أن يلمسها مرةً أخرى في سمة الهندسة المعمارية التي أضافت الحركية واحتفاليّة الباروكية إلى الهندسة المعمارية»، ثم يضيف: «إن مركز الحضارة الأندلسيّة، المتمثل في قرطبة، تألّق على أرض أوروبية، ويمكن لهذا المركز أن يضفي الشرعيّة على حضور المسلمين في أوروبا». (انظر الكتاب وبخاصة الفصل المهم: الإسلام في أوروبا).
شكّل التزامن بين صعود التنظيمات المتطرفة من جهة، وغليان الزحف للاجئين السوريين في أوروبا من جهةٍ أخرى، مجال أرقٍ استثنائي لم يسبق له مثيل منذ 2001، إذ تتحدّث الصحف والقنوات يوميًا عن موضوع الإرهاب والخطاب الديني والمنابر ورجال الدين، وهذا يمنح المسلمين وزعماءهم فرصة كبرى لبدء عمليّة غربلة تهيئ لتعاملٍ استثنائي لوضع مشروعٍ لن يكون سهلاً لتبرئة الدين من الإرهاب ومخاطبة الأمم الأخرى بذلك، وهذا ليس مستحيلاً، فنواة هذا الإصلاح بدأت منذ موجة التنوير العربي في عشرينات القرن الماضي، علينا أن نبدأ هذا الجهد لئلا يصحّ على منطقتنا وصف القتل والدم والإرهاب.. يروي الزعيم اللبناني وليد جنبلاط عن أمه مي أرسلان ابنة الأديب الإصلاحي شكيب أرسلان ومؤلف كتاب «لماذا تأخر المسلمون وتقدّم غيرهم» 1930، أن آخر كلمةٍ تمتمت بها قبل أن ترحل: «العالم العربي.. عالمٌ من القتَلة».