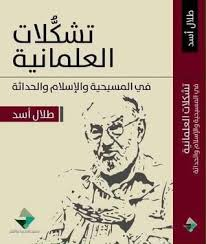نوفمبر
23
العالم بعيون غير يسارية
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 17 نوفمبر 2016

يمكن اعتبار فوز دونالد ترامب مجرّد رأس جبل الجليد لأفكار الانغلاق الاجتماعي، وصعود الهوية المركزية، وانقضاء زمن العولمة الذي انتعش في الربع الأخير من القرن العشرين. الاضطراب الذي يعصف بمنطقة الشرق الأوسط سياسيًا، والأوجاع الاقتصادية التي ضربت الجميع ستكون مؤثرةً على شكل الالتقاء بين المجتمعات، في العالم، بما ينذر بدخول زمن الانكفاء والتحفّز والانعزال، بدلاً من عقود تواصل والتقاء كانت بلغت أوجها قبل أن تتراجع تدريجيًا بدءًا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).
مجيء ترامب مجرد ثيمة لحقبةٍ قد نرى آثارها قريبًا علامتها تراجع أفكار اليسار الغربي، وصعود أحزاب اليمين. وإذا كانت الصيحة المحافظة في واشنطن، فإن الإجابة عنها في أوروبا، أحزاب يمينية تسعى بجهدٍ حثيث للفوز وبخاصة في ألمانيا وفرنسا.
تحديات اللاجئين، والمهاجرين غير الشرعيين، وتصاعد النبرة التفاوتيّة بين المجتمع الواحد هو ما يجعل من انتعاش اليسار في المرحلة الحاليّة أمرًا صعبًا. الضغط الثوري في المنطقة، وتهاوي المؤسسات السياسية، وتلاشي أدوار السلطات تعزز التشوّف إلى أحزاب انعزاليّةٍ تعزز الهويّة المركزية، وتميّز المواطنين الأصليين عن المواطنين الآخرين. ثمة إلحاح على الدور اليساري في التغيير الثوري، نقرأ مثلاً لمفكر يساري مثل سلافي جيجك: «أن استمرار تجاهل الليبراليين المعتدلين لليسار الراديكالي إنما هم يولّدون موجة أصولية تكتسح كل شيء، إذ إن إسقاط الطغاة هو المطلب الذي يهتف له كل الليبراليين الأخيار، إنها ببساطة مقدمة السعي الدؤوب صوب التحولات الاجتماعية الجذرية، والتي من دونها تكون عودة الأصولية، في عالمٍ كل شيء فيه تحت رحمة رأس المال، فإن السياسات الراديكالية فحسب ستنقذ كل ما هو ذو قيمة في الإرث الليبرالي» هذا ما يشرحه بالنيابة عنه تيري إيغلتون، صاحب كتاب «أوهام ما بعد الحداثة» الذي قرأ فلسفات الاختلاف كما يقول بمنظور «اشتراكي» والمهتم بمراجعة مقولات جيجك.
بعض الطروحات تتحدث عن انكساراتٍ لليسار حتى في أميركا الجنوبية، لكنه تراجع طفيف، لا يمكن مقارنته بالذي يجري في دول أوروبية والولايات المتحدة، مع أن اليسارية الغربيّة بحلتها المعدلة عن اللينينية جعلتها نقطة التقاء بين تياراتٍ متنوّعة في أهدافها وأشكالها ومستوياتها بامتداد الجذور بما يعيدها إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، والنكسة التي يعيشها غربيًا لم يحدث منذ نضجه وانتشاره الآيديولوجي عام 1945.
يأتي تصاعد اليمين رغبةً في تغليب القوة على الحق، وتخفيف طغيان الوسيلة الحميدة، رغبةً في الغائية الأكيدة مهما كانت أخلاقية الوسائل الموصلة إلى النمط المراد اجتماعيًا. الهدف تحقيق الشكل الاجتماعي ضمن القوانين المزمعة والمحمية من الأحزاب السياسية الراغبة في تخفيف التواصل، وإغلاق الفضاءات الجامعة، ولجم العولمة المقوّضة للهويات والمهدّمة للحدود، والمخففة للصراع بين الأمم والحضارات والثقافات والهويات.
قد تكون النزعات المحافظة الصاعدة مركّبة ضمن صيغةٍ جديدة، تجمع بين تاريخ التواصل وإرثه، وصناعة أشكال انعزاليّة ضمن أسس ليبرالية محددة لكنها ليست مندفعةً نحو الغريب، هذا مؤشرٌ يطرحه مفكر بارز مثل داريوش شايغان في كتابه الجديد: «هوية بأربعين وجهًا» في فصلٍ مهم لافت بعنوان «كيف أمسى العالم شبحًا»، وها نحنُ نشهد بسبب عدم تناغم مجموعة من العوالم الممزقة، انبثاق ظواهر جديدة تمام الجدة. ثمة نزعة روحية تتحرك بموازاة التطورات التقنية المذهلة، فقد عادت إلى الظهور معتقدات منسوخة بامتياز، صاغتها حضارات قديمة، ومعها أتباع الشمس، وشتى صنوف الفرق الدينية، والمتنبئون بالمستقبل والمؤمنون بأسرار الألفية ونهاية العالم.. سمة الإرباك والفوضى في عصرنا هي بالضبط ما يمكن نعته بفقدان الإحداثيات». كل القوالب تتكسر، والأشكال المطقّمة تتغيّر.
المؤشر الأهم في ظل النتائج السياسية، وارتفاع أرصدة المحافظة والتقوقع، أن المجال الرحب المعولم لن يكون كما هو مستقبلاً، إذ ستبدو تيارات أكثر قدرةً على حراسة الهويّات الأصلية، والنزوع نحو التمييز، وتشجيع أفكار التفاوت. الاضطراب السياسي سيعزز من ارتباط الحق الذاتي بالسلطة، وهي قد تكون استعادة وتدويرًا لفلسفة توماس هوبز المؤوية للسلطة في جيب الحقيقة، والرابطة بين الحق والسلطة، والجاعلة من الفرد والدولة والمجتمع مكوّناتٍ للحقيقة، وما الحق إلا ما نبع من ظهور السلطة. وسبب ذلك تلاشي الجدوى الثورية، وتفاقم الأعباء الناجمة عن المساواتيّة، وربما نشهد أمرًا موحشًا يتمثّل في «تقنين فائض المشاعر الإنسانية» لصالح الانتصار للتركيبة السكانية، بسبب ازدياد حالات اللجوء والهروب، انطلاقًا من التفكك السياسي كما في ليبيا وسوريا والساحل الأفريقي، أو الأزمات الاقتصادية في شمال أفريقيا، وربما العامل الديني إذا ما تقدّم «داعش» واحتل مساحاتٍ أخرى خارج العراق وسوريا، كل ذلك ينشّط حالات المحافظة ويغري المجتمعات بأفكار أكثر انكفاءً، وقد يتضاءل استيعاب تيارات اليسار بسبب ارتباط الجماعات الإرهابية بأفكار يعتبرها اليساريون محقّة كما في اعتبار حركات فلسطينية بوصفها جماعات مقاومة، بينما تجري مذابح وسط باريس من جماعاتٍ أخرى رديفة موازية.
إنه زمن مختلف، بعناوين جديدة، بمسميات جديدة، وكل ذلك بسبب تنامي الاضطراب في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكل ما نعيشه شاهد على الانكماش، لم يعد العالم مقروءًا بعيون يسارية كما هي مقولة إيغلتون عن رؤية جيجك.
نوفمبر
03
أوبرا في الخليج … مسرحة الوجود وتحوّلات التاريخ
فهد الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 3 نوفمبر 2016

على مقربةٍ من «برج خليفة» رصّعت جوهرة «دار الأوبرا» في دبي، من تصميم المكتب الهندسي البريطاني «أتكنز»، ومن إبداع المهندس جانوس روستوك، حين دلفتُ لأوّل مرة رأيت صديقًا أكاديميًا سبق أن عاتبني على مقالةٍ كتبتها قبل ثمانٍ سنواتٍ بعنوان: «قد يأتي النور من الخليج» كانت حول تجربة دبي الرائدة، تبيّن أنه أقام في دبي وانتقل إلى العمل بها. المبنى الكلاسيكي المجهّز بأحدث التقنيات السمعية والبصرية يعيدك إلى الأفلام الكلاسيكية القديمة؛ نزعة من الأصالة، مع حيويّة فنيّة تذكّرك بمقولة فورجاك: «الأوبرا هي المجتمع كله مجسّدًا على المسرح في دراما بصريّة وسمعية». مبنى يحاكي فكرة الأوبرا حيث التعاضد بين الموسيقى والدراما في جذورها الإغريقية، إذ يبدو العالم كله مسرحًا، والأحداث قصصًا درامية، والعواطف تنطق شعرًا بألوان الحبر والدم، تعيدك إلى أوائل المسرحيين الإغريق من مثل سوفليكس، وبوربيديس، وإيسخوليس، إلى جذور الموسيقى المسرحية، حيث الوجود كله مسرح، والإنسان على المنصّة كائن يبكي أو يرقص.
بالتزامن مع أوبرا دبي، افتتحت دار أوبرا خليجية أخرى في الكويت، هذه الصروح الثقافية والفنيّة تعكس مستوى الإرادة الاجتماعية الراغبة في الاستقرار السياسي. بنيت أول دار أوبرا في البندقيّة عام 1637، بينما أوبرا هامبورغ في ألمانيا بنيت عام 1678. تتنازع الأوبرا بين الموسيقي والدرامي تبعًا لتطوّر المجتمعات وتغيّر العصور. الراصد المهم لتاريخ الأوبرا نذير جزماتي يذكر في كتابه المرجعي «الأوبرا» أن «المغنّين والملحنين وباقي الأوبراليين الإيطاليين الذين حملوا فنّهم إلى مختلف بقاع أوروبا، وعاشوا عصرهم الذهبي في القرن السابع عشر، يقدمون الجانب الموسيقي في الأوبرا على الجانب الدرامي، ووقف على رأس هذه المدرسة الساندرو سكارلاتي، فقاد كريستوف ويليبالد فون غلوك (1714 – 1787) الثورة الثانية في تاريخ الأوبرا، حيث أحدث التوازن عام 1762 بين الموسيقى والدراما، ويعتبر غلوك الأب الطبيعي لمدرسة فيردي، فاغنر، ديبوس، التي لا مثيل لها في عالم الأوبرا، ومع انفجار الأحداث الفرنسية الكبرى في أواخر القرن الثامن عشر أخذت المواضيع القومية والرومانسية تحلّ محلّ المواضيع العامة في الساحة الدرامية، وأخذت الموسيقى تنهل من الينابيع الشعبية، فاعتبر موتزارت ممثلاً لروح جان جاك روسو، بينما بيتهوفن وروسيني ودونيزيني، ثوارًا بمعنى الكلمة».
دُور الأوبرا ليست مستودعًا للإلقاء، أو منصةً للترفيه، أو حاويةً للمعزوفات فحسب، بل تشكّل الوعي، وترسم الحوارات الفكرية السياسية، وتؤسس للنظرة المجتمعية للواقع والعالم، وهي ليست منفصلةً عن الشعبيات، نتذكر إسهام أسطورة الأوبرا بافاروتي الذي غنّى الفنون الشعبية والأوبرا على حدٍ سواء، بل استطاع نشر الأوبرا شعبيًا في إيطاليا وأوروبا والولايات المتحدة منطلقًا من أدائه الاستثنائي. من هنا تغرس الأوبرا مفاهيم جديدة باعتبارها خلقًا مسرحيًا، وتكوينًا حواريًا، وفضاء وجوديًا، وتحايث الأوبرا حادثات الزمان، وتغيّر وتتغير باعتبارات المكان، فهي جزء من الحوار الأبدي بين الإنسان والوجود، وقد ترفع من مستويات التغيير الخفيّ، عبر الأفكار المخترقة والمتسللة إلى الأذهان، وعلى حد تعبير نيتشه فإن «الكلمات الأكثر هدوءًا هي التي تستدرج قدوم الإعصار، وإن كلمات تتقدم على أرجل حمام لهي التي توجه العالم».
جُمل الموسيقى، وصروح الأوبرا، والمسرحة الفنيّة كلها تحتضن تاريخ الشعوب. في ألمانيا وشمت الحروب في الموسيقى، وأثرت الصراعات وعاتيات الأحداث على «الأثر الفني»، وقد استخدم نيتشه الموسيقى الألمانية لنقد التاريخ وضربه بمطرقة «الجينالوجيا» العتيدة حين يتحدّث عن النفس الأوروبية والموسيقى الألمانية في شذرة 245 من كتابه: «ما وراء الخير والشر»، متسائلاً: «أين الأيام الخوالي المجيدة، صداها خفت مع موتزارت وموسيقاه، كم نحن سعداء الحظ لأن الروكوك ما زال يكلّمنا، ولأن لطف صحبته، وحماسة الجنون، والطُرف الصينية والزخرفة، ولأن لطافة قلبه، وإيمانه بالجنوب وتوقه إلى الرقّة والحب والرقص والتشبيب ما زال له أن يناجي بقيّة باقيةً فينا، واأسفاه إذ عاجلاً أم آجلاً، ولكن من يراوده الشكّ بأننا، في القريب العاجل، سنكفّ عن تذوق بيتهوفن، وفهمه، وهو لم يكن سوى الرنين الأخير لموسيقى في طور الانتقال ولقطع أسلوبي، ولم يكن مثل موتزارت فصلاً ختاميًا لذوق أوروبي ساد طوال قرون. إن بيتهوفن هو حدثٌ بيْن بين، يجمع بين نفس عجوزٍ واهنة، تنكسر باستمرار، ونفسٍ آتيةٍ مفرطةٍ في الفتوة لا تنفك تأتي، موسيقاه تخيّم بين ثنائية نورٍ ينبئ بهلاكٍ أبدي، وأمل خالد جامح».
تحاور الأوبرا، والمعزوفات الموسيقية، غياهب التاريخ، والقطع الموسيقية توثق بصمتها وقائع سياسية، وثورات استثنائية، وحمم بركانية، هي عناوين على القطائع التاريخية، والذروات السياسية، والانفجارات الشعبية. إن الأوبرا في دبي والكويت هي «النور» والنور قد يأتي من الخليج، بل أتى بالفعل منه.
في أوبرا ريتشارد فاغنر Tristan und Isolde :”يستلقي تريستان المصاب بجرحٍ بليغ، على أريكةٍ دون أن يقوم بأي حركة، وعن كثبٍ يراقبه كورفينال الواقف إلى جانبه، ومن وراء السور يأتي صوت الناي الحزين، ويظهر الراعي الشاب الذي كان يسأل إن كان تريستان لازال نائماً، ويجيبه كورفينال بصوتٍ حزين، أنه إذا استفاق مات، وطلب من الراعي أن يراقب أي أثرٍ لباخرةٍ في الأفق البعيد، وأنه إذا وجد باخرةً فما عليه إلا أن يغيّر لحنه الحزين إلى لحنٍ مفرح”.
نوفمبر
03
من “الأمة” إلى “القوميّة” …جهاد مابعد القاعدة
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 20 أكتوبر 2016
استثمرت «القاعدة» في الثلث الأخير من القرن العشرين الأوعية المنجزة حداثيًا وعولميًا، واستطاعت أن تتلبّس الأنماط المعاصرة بغية الوصول إلى الأهداف ومن ثم التجنيد والاستهداف. تحوّلت «القاعدة» إلى شركة عابرة للقارات والحدود مثل مطاعم الوجبات السريعة ضمن إدارة مركزية واحدة. كانت تحاكي سلوك الحداثة، حيث «التغيير العام»، و«إقناع الآخرين» بالمشروع المتثمّل في ضرورة مقاومة «الصليبيين» واستثمار المتعلّمين لتجنيدهم. السجال الفقهي طغى على الكوادر القاعدية، الأهداف المثاليّة مثل «إخراج المشركين من جزيرة العرب» وصولاً إلى تدمير مصالح الولايات المتحدة، واقتياد عدد من الطائرات فوق سماء مانهاتن لتفجير برجين. «القاعدة» نمط معولم أكثر سكونًا تنتظمه مركزية إدارية في معظم الأوقات. مقارنات الحداثة وأوعيتها كلاسيكيًا استثمرت إرهابيًا من خلال توجيه الطفرات العلمية الحرة وتوظيفها ارتجاعيًا لصالح ثقافة الاستئصال. مفاهيم مثل التواصل، والتقنية، ونشر المعلومة، والحوار، ونشر الأفكار، كلها جاءت ضمن سياق حداثي، لكنها استثمرت قاعديًا وجعلت من تاريخها الماضي نمطًا للإرهاب الكلاسيكي المبرمج، حيث بقيت لعقود تقوم بعمليةٍ واحدة بمعدل كل سنتين، تلك هي «القاعدة».
«داعش» منذ دخوله الموصل في يونيو (حزيران) 2014 وهو يطرح نموذجًا بديلاً للتعامل مع حركة وإيقاع العالم. استولى بعد الموصل على أجزاء من حلب نحو الصحراء السورية وعلى محافظتي الأنبار ونينوى في العراق. عودة «داعش» إلى العراق بقوة توّجت من قبل بالاستيلاء على مدن كبرى في سوريا محاولاً تحطيم الحدود الفاصلة بين البلدين. استخدم تكتيكًا أطلق عليه «كسر الحدود» ونجح في استثمار العلاقة المتدهورة بين الحكومة المركزية والجماعة السنيّة. أراد «داعش» خلق «نهايات الجغرافيا» يزحف على أرضها، وبذلك تكوين قوميّات منفصلة تدين بالولاء له، واستثمر غضب مجاميع سنية من المصير المقبل، وهرعت إليه هربًا من «جبهة النصرة» ليثبت من بعد أن «داعش» أحدث الصرعات الإرهابية ليست امتدادًا جوهريًا لتنظيم القاعدة، بل هي خروج عليه. «داعش» هي حركة جهاد ما بعد «القاعدة».. جهاد ما بعد العولمة، وما هو أبعد من الحداثة البعدية، فهي: تعتمد على الهوامش، تحارب المراكز، الجغرافيا منتهية، صيغ العولمة باتت قديمة، تعيش في تجنيدها على الألعاب الإلكترونية، والـ«سوشيال ميديا»، وتهتم بالمنتج البصري أكثر من البحثي، سينمائية في عرضها وتحشيدها، تعتمد «الأزياء» الخاصة بها، لا داعي للمزيد من العلم الشرعي، التطبيع مع عوام المسلمين، المعرفة بالدين ليست أساسية، الدولة أهم من الشريعة، نقد إرهاب «القاعدة» باعتباره إرهابًا قديمًا. بين «القاعدة» و«داعش» كانت قنطرة التحوّل والتجاوز من خلال أبي مصعب الزرقاوي الحلقة الفاصلة بين الكلاسيكية الإرهابية، والموجة الداعشية الصاعدة. «القاعدة» استثمرت مناخًا كلاسيكيًا قديمًا، «داعش» تعيش صيغ التقنية بأعتى الأساليب، تعتمد على الفئات الاجتماعية أكثر من اعتمادها على المجتمع الكلي، لا تحتاج إلى تدريب أشخاص لسنوات من أجل قيادة طائرة واستهداف أبراج، بل يجيء الإرهابي السريع الأكثر رخصًا في التجنيد والقتل، «الذئب المنفرد» يهجم على مدينته التي يسكنها من أجل الخليفة البغدادي، هنا يتحوّل الإرهاب من مسار واحد يتبعه الجميع، إلى «دروب متعددة».. «داعش» تمارس تقويض «القاعدة» وتضربها بمطرقة باعتبارها تحمل عوائق أخلاقية لا تريدها «داعش» ولا تعتبرها شرطًا، هذه صرعة إرهاب ما بعد كلاسيكي، إنه يستثمر حتى الأعراق في بناء النظرية.
الحروب في سوريا والعراق، وبخاصة بعد حرب الموصل ستجعل العمل الإرهابي أعم من الهدف الديني، تتحوّل الحركة إلى وسيلة نصر قومي كما فعلت «طالبان»، «القاعدة» لم تتخذ مواقف مذهبيّة صارمة. بالنسبة إليها العالم فسطاطان؛ كفر وإسلام، لكن الشيعة مثلاً لم يكونوا هاجسًا لدى بن لادن، وإن كانوا كذلك لدى الزرقاوي، لكن لدى «داعش» ألف فسطاطٍ للحرب، تحتل تصفية الأقليات أولويّة. «داعش» ستستثمر المعاني القوميّة، تطرح نفسها بوصفها «قوميّة بديلة». يطرح الدكتور طلال أسد في كتابه الحديث: «تشكيلات العلمانية» سؤالاً: هل ينبغي أن ينظر إلى الإسلام السياسي بوصفه قوميّة، يقارب ذلك: «دعونا نسلّم بأن القوميّة علمانيّة الجوهر، بمعنى أنها تضرب بجذورٍ عميقةٍ في التاريخ والمجتمع الإنساني، والسؤال الذي يطرح نفسه أمامنا الآن هو: هل بإمكاننا الآن أن نجادل من الاتجاه المعاكس بالقول إن بعض الحركات التي بدأت دينية ينبغي أن ينظر إليها بوصفها حركات مناصرة للقومية، وبوصفها في الواقع تعدّ كذلك حركات علمانية؟ وقد تبنّى هذا الجدال الكثير من المراقبين للإسلام السياسي». ثم يضيف أن هذه الظاهرة هي «استمرار للسردية المألوفة حول قوميّة العالم الثالث».
شكّل تفجير البرجين إعلانًا عن نهايات كثيرة تتعلق بالعولمة والحداثة وصيغ الاقتصاد وأسس الصراع الحضاري والديني، ولكنه قبل ذلك أعلن عن نهاية أنماط الإرهاب القديمة، لتدلف المجتمعات أمام إرهاب ما بعد عولمي، جهاد متشعّب بدروب كثيرة ضمن كسر للجغرافيا وإنهاء للمسار الإرهابي الواحد، وهذا ما يجعل تنظيم داعش أخطر الظواهر الإرهابية على الإطلاق بحيث يصعب القضاء عليها ضمن الاستراتيجيات المحدودة المطروحة. كتبت حنة أرندت في كتابها «أسس التوتاليتارية» عن الإرهاب بشكله الكلّي العام: «إنه الذي يجعل الناس يسحق بعضهم بعضًا».