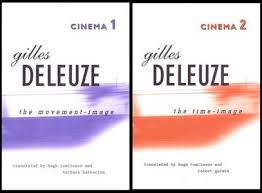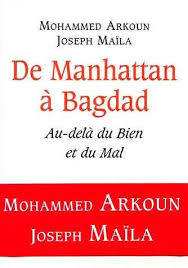أبريل
27
سينما الصدفة… دهشة دلوز من وميض بريسون
جريدة الشرق الأوسط 27 أبريل 2017
فهد سليمان الشقيران
تربت الصورة على كتف المشاهد بسطوعها عبر وميض الفيلم، تُسيّل الشخصيات، وتُنحت وتصاغ البطولات، وتُشعَل نيران العواطف، وترمي الصور شرر أيقوناتٍ، وتمرّ المعاني عبر الثيمات والعلامات، والصورة السينمائية سطح ممهّد لأنواع المسرحة والركض، بها يصنع الوهم الجميل، ويشيّد الواقع بقبحه وجماله، تجيء السينما لتكون أخصّ من الصورة بزمانيتها ومكانيتها، لتكون الفضاء الكاسر للحدّ التعريفي وللحدود المكانية.
تشتغل السينما على اللحظة، والومضة، والسمة، وهي شغّالة على الجزء من بين الكل، وربما صنعت ثيمة شاملة ضمن مشروعٍ إخراجي، أو تركيز بصري، كما في التركيز على «اليد» في أفلام روبير بريسون، وهي موضع محاضرة للفيلسوف الفرنسي جيل دلوز، يستطرد حول موضوع «اليد في سينما بريسون» يتحدث بصوتٍ متهدّج وبذهول: «إن السينما تحتوي على الكثير من أشكال الفلسفة، غير أن المسافة عند بريسون تعتبر شكلاً مميزاً من أشكال المسافة، وتم تجديدها واستخدامها مرة أخرى وبطرقٍ إبداعية، من قبل مبدعين آخرين، ولكني أعتقد أن بريسون كان من أوائل من صنعوا المسافة من خلال قطعٍ صغيرة غير متصلة فيما بينها، بمعنى أنها قطع صغيرة لم يتم تحديد اتصالها بشكلٍ محدد سلفاً، وحينما أقول دائماً إنه في كل أشكال الإبداع نجد العلاقة (مسافة زمن) هناك فقط المسافة والزمن، ولا شيء غيرهما، هنا تتجه كل الحركة والزمن لدى بريسون إلى هذا النوع من المسافة. إن هذا النوع البريسوني من المسافة والقيمة السينماتوغرافية لليد في الصورة مرتبطان بلا شك، إن اتصال القطع الصغيرة من المسافة البريسونية التي ليست إلا قطعاً صغيرة غير مرتبطة فيما بينها لا يمكن أن تترابط إلا عن طريق اليد، وحدها اليد هي القادرة على خلق رابطة بين الجزء والآخر من المسافة، بريسون بلا شك هو أعظم المخرجين الذين أضافوا قيم الملموس إلى عالم السينما، وهذا ليس لأنه عرف كيف يصور تلك الأيدي ببراعة، لكنه إذا كان يجيد تصوير الأيدي ببراعة؛ فذلك لأنه في حاجة إلى تلك الأيدي».
شغل جيل دلوز على السينما يتجاوز الإشارة العاجلة لدى أفلاطون في صورة «الكهف»، وتعدّى البحث البصري لدى برغسون، ليشهد النصف الأخير من القرن العشرين اهتماماً كبيراً بالسينما. صحيح أنها كانت موضوعاً عابراً لدى جاك دريدا وفوكو، لكنها ستكون من صميم نظرية جيل دلوز الفلسفية بشمولها، ذلك أن النظرية الدلوزية تقوم على «صناعة المفاهيم»، وفي كتابه «ما الفلسفة» يعتبر المفهوم يمتلك دائماً تاريخاً حتى وإن كان هذا التاريخ متعرجاً، ويمر من خلال مشكلاتٍ أخرى أو فوق «المسطّحات المحايثة» المنفتحة على اللامتناهي، ويشتمل المفهوم على أجزاء ومكوّناتٍ آتية من مفاهيم أخرى، تكون قد أجابت عن مشكلاتٍ أخرى، وقد افترضت مستوياتٍ أخرى، هذا أمر لا محيد عنه لأن كل مفهومٍ يقوم بتقطيعٍ جديد، ورسم محيطاتٍ جديدة، مما يتطلب إعادة تفعيله وتفصيله ثانية، وبالنسبة إلى دلوز واهتمامه بالفلسفة فإن: «الفن والفلسفة يتابعان الاستقطاع في السديم ويواجهانه، ولكن لا يحدث ذلك فوق مسطّح المحايثة في القطعية عينها، ولا يجري ذلك بعين الطريقة في إشغاله؛ إذ لدينا في الفن كوكباتٍ كونية، ومؤثرات انفعالية، ومؤثرات إدراكية».
مدخل دلوز إلى الحفر الفلسفي في الشريط السينمائي من مفهمته الفلسفية (للهوامات والشبه) Simulacres et fantasmes، ويعني الصورة السائلة المنزلقة، السابحة على سطح الماء؛ ولأن كل فلسفة دلوز هي فلسفة (سطوح، وسطوع) فإنها وجدت في السينما مساحة لاستعراض الألعاب المفهومية في المسافة والزمن والتقطيع، والمفهوم الذي هو عصب فلسفة دلوز مثل الصورة له تاريخه ونموّه، وفي جوفه يحمل احتمالات الفعل والعطل، ودلوز مشهور بدراساته حول الفلاسفة الذين يأخذهم كأقانيم يختبر من خلالها مفاهيمه، كما في كتبه الشهيرة التي أفردها لنيتشه وكانط وديفيد هيوم واسبينوزا. كتب مستقلة تشرح فلسفة الاسم موضع البحث بنفس مستوى شرحها فلسفة جيل دلوز؛ فهي فلسفة قراءة، ومخاتلة، ومباغتة، وإعادة تعريف.
على الصعيد (السينمافلسفي) فإذا قرأنا كتاب جيل دلوز الثري «سينما الصورة، الحركة والزمن» نجد تطبيقاتٍ سينمائية على التعريف الدلوزي للفلسفة؛ إذ الأشياء بالنسبة إليه هي «إمساكات كليّة موضوعية، بينما إدراكات الأشياء هي جزئية ومتحيزة وذاتية، وإذا لم يكن الإدراك الطبيعي نموذجاً للسينما، فلأن حركيّة مراكزها وتبدل كادراتها دفعا بها دائماً إلى استعادة مناطق لاممركزة واسعة، ولم تضبط لقطاتها، عندئذٍ تسعى إلى بلوغ النظام الأول للصورة – الحركة، أي التبدل الشامل والإدراك الكلي والموضوعي المنتشر».
بمعنى ما، فإن السينما تحوي مساحاتٍ شاسعة تتحرك فيها الهوامات والشبه، وتخلق فيها المفاهيم كالعرائس، فالفيلسوف – كما يعبّر دلوز – لا يكون فيلسوفاً إلا إذا صارت «اللافلسفة» أرض الفلسفة وشعبها، هنا تصنع المعرفة السحر حين تغزو المجالات الأخرى باحثة وفاحصة، وفي محاضرة له تحدّث الفيلسوف عن سر اهتمامه بالسينما محاولاً البحث في الحافز على ذلك، غير أنه لم يجب بشكلٍ قاطع؛ مما يجعل فلسفته وطبيعة تعريفاته تجذبها الحالة البصرية السينمائية فهو مراوغ مغامر، يسكن الفلسفة، لكنه يريد الهجرة إلى السينما، لكنها هجرة متخيّلة؛ إذ كان وعاش ورحل وهو أهم فلاسفة عصره على الإطلاق، تلك ومضة عن سحر قاعة السينما وشاشتها؛ إذ تحتوي على غرائب دلالية مفاجئة.
أبريل
20
أوبرا في الرياض… المجتمع على خطى العالم
جريدة الشرق الأوسط 20 أبريل 2017
فهد سليمان الشقيران
تدخل الموسيقى بأصنافها على عواصم الخليج ودور الأوبرا. مجتمعاتها الذوّيقة لعيون المعزوفات، والطربة للأهازيج والمواويل، لديها الرغبة في أن يتعاضد ارتفاع مستوى الرفاه مع مستوى الترفيه. خلال السنوات الماضية كنت أحضر بين وقت وآخر بعض أمسيات مهرجان أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية، وحدث أن وفقنا بحفلة للموسيقار دانيال بيرنباوم؛ عازف عالمي ذائع الصيت يندر وجود من ينافسه من الأحياء، ومثقف، وصاحب رأي سياسي، وتربطه صداقة متينة بإدوارد سعيد، ويوصف بـ«محب الفلسطينيين». لم أحضر بمستوى ذلك العزف من بعد على الإطلاق.
من الرائع عيش مرحلة الموسيقى في عواصم الخليج… الموسيقى الكلاسيكية الحيّة المعبرة عن رقي الذوق، والصادرة عن عباقرة لم يكونوا مجرد عازفين، بل ارتبطوا بتاريخ مع الفلسفة والأدب والشعر.
مؤخراً عزفت لأول مرة «أوبرا» في السعودية، في «مركز الملك فهد الثقافي»، من قبل أوركسترا يابانية، تنوّعت بمختاراتها، وقد عُزفت بعض أعمال تشايكوفيسكي، وهذا فوق عبقريته الموسيقية، لديه اهتمامات فلسفية؛ فهو صاحب نقد لمبادئ آرثر شوبنهاور، وله تعليقات على آراء تولستوي الفلسفية، وفلاديمير سولوفيوف، وتشيتشيرين، وفي آخر حياته درس اسبينوزا. الموسيقى الصادرة من أولئك العباقرة بكل ثيماتها الموسيقية، أو الرمزية الأوبرالية تكرع من ينابيع التاريخ والصراع المجتمعي والأمواج الفلسفية المتلاطمة، وهي نتاج تصدّع بين تناقضات العالم. بمعنى آخر، فإن الموسيقى بحضورها تساهم في رفع مستوى الرؤية والذوق، وتسهل للإنسان أن يخرج من السياجات التي رضي بها، أو فرضت عليه.
في الرابع من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي التقى وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل الطريفي بجمع من المسؤولين اليابانيين، واستفاض بالحديث عن تمكين الموسيقى والثقافة في السعودية؛ الوزير معروف لدى المثقفين باهتمامه بالموسيقى الكلاسيكية، بالأوبرا العالمية، ولديه آراؤه المستقلة حول السيمفونيات والمقطوعات، ويستظهر القطع الموسيقية من قلب الأفلام السينمائية الخالدة، وقد تحدّث آنذاك عن رغبته في تمكين الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية، يتحدّث قائلاً: «أنا من محبي الموسيقى الكلاسيكية، وأوبرا (برامز) هي ربما أفضل مُؤَلَّفة موسيقية على الإطلاق، وأنا أستمع إليها جميعاً، لكن كونشرتو البيانو رقم (2) هو العمل الموسيقي المفضل بالنسبة إليّ، خاصة حين أعاد تقديمه المؤلف الموسيقي النمساوي كارايان في ستينات القرن الماضي، وأعتقد أنه يحظى بشهرة واسعة في اليابان، وأود أن أشاهد يوماً ما شاباً سعودياً يمكنه العزف على آلة (التشيلو) على الصعيد العالمي، كما الفنان الشهير يويو ما، وأود أن أرى فتاة شابة مثل جاكلين دو بري، وهي فنانة رائعة هي الأخرى في العزف على آلة (التشيلو)… فأنا أتصور أن هناك طاقة كبرى لدى الشباب السعودي، ونحن بحاجة إلى أن نُمَكِّنَهم من متابعة دوافعهم، وأهدافهم وطموحاتهم في مجال الفنون والثقافة، وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة إليّ».
بعد ذلك الحديث، تحققت أمنية المجتمع من خلال وعد الوزير، وآية ذلك تلك الأعداد الغفيرة المتقاطرة على القاعة بغية الظفر بتذكرة الحضور. نفدت التذاكر ولم تنجح محاولات الفوز بمقعد في اللحظة الأخيرة، والفيديوهات التي تم تداولها على مواقع «التفاعل» بيّنت الانسجام المطلق، والفرح الغامر، والانهماك التام مع تلك النوتات الآسرة والساحرة. ورغم حداثة حالة الحفلات الأوبرالية أو الموسيقية الكلاسيكية، فإن المجتمع السعودي لديه علاقته المستمرة مع الموسيقى عبر الراديو، والتلفزيون، ومن ثم الأقراص المدمجة، والإنترنت، لكن علاقته تجددت بأن يحضر حفلة متكاملة بنفسه بدلاً من سماعها عبر وسائل وسيطة أياً كانت.
الأوبرا بمعناها العميق منذ نواتها الإغريقية، وتأثرها بالأدعية الهندية، والمجالس الفارسية، هي حالة حوار مستمر بين الإنسان وما حوله من الأشياء، أساسها الاستفسار، الرغبة في سماع صوت آخر يجيب، هي تفجّر بين السؤال والجواب، بين الروح والجسد، بين الحقيقة والاحتمال، بين النور والظلمة، بين الليل والنهار، بين الماء والنار، هي رصد إنساني فني لحال التناقضات، وبها استجابة لبذرة الدهشة في الإنسان، وأصالة السؤال، وحيوية الاكتشاف. إنها تهذّب المجتمعات وترفع من مستوى سكونها، وانفتاحها على الأصوات الأخرى، الأوبرا بمسرحتها واكتمالها صيغة إحراج للجمود، تجمع بين الموسيقى والفكرة، وحوار المجتمع، والحب والكره، وصراع الخير والشر، كما في سحر أوبرا «كارمن» الأعظم لجورج بيزيه (1875) الخالدة بفاتحتها وخاتمتها الدرامية من السكون إلى الشقاء؛ من التعلق بالفتاة الفاتنة، وحتى طعنها والذهاب إلى حكمٍ بالإعدام.. أوبرا فاتنة، تعبر عن كل التناقض والوميض واللحاظ التي يغشاها الإنسان يومياً في حياته من دون إدراك.
قبل قرنين من الزمان كتب الشاعر البريطاني اللورد بايرون: «هناك موسيقى في تنهّد القصبة. هناك موسيقى في فورة الساقية. هناك موسيقى في كل شيء، لو أمكن البشر سماعها، فأرضهم ليست سوى صدى الأجواء».
أبريل
13
ضربة ترمب… «نهاية الخطّة الشريرة»
جريدة الشرق الأوسط 13 أبريل 2017
فهد بن سليمان الشقيران

ارتبطت الضربة الأميركية الترمبية بسيلٍ من الاستعادة حدّ السخرية لخطابات وقرارات الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، المتفرج بدمٍ بارد على الأزمة السورية، برغم الخطوط الحمر، وتحديد نهاية الصلاحية لرئيس النظام، واجتماعاته الكثيرة، وتصريحاته التي لا تحصى، وخططه الورقية، غير أنه لم يفعل شيئاً تجاه الأزمة السورية على الإطلاق، بل كان لفترة يسخر من تحميل أميركا أوزار التدخل وأثمانه الباهظة، مشبّهاً أي عملٍ عسكري بسوريا بفض نزاعٍ اعتباطي بأحد أدغال أفريقيا، مما جعل أسماء سياسية لامعة بالولايات المتحدة تتعجب من هذا الأفول والانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط، وإخلاء المنطقة لروسيا وإيران وأذرعها الإرهابية الميليشياوية الدموية والمافياوية. اقتصر تدخله على دعمٍ لوجيستي محدد بليبيا، لم تعد أميركا الأمة «التي لا يمكن الاستغناء عنها» كما عبّر مرة بيل كلينتون، بل باتت معه «الأمة التي يمكن الاستغناء عنها»، حيث يردّ والي نصر على سياسات أوباما بكتابه بالعنوان ذاته، راسماً على شرحه «السياسة الخارجية في تراجع»، لكن هل تبقى كذلك بعد الضربة الترمبية الاستراتيجية؟!
العقيدة السياسية – التي تعبّر عنها صيغ الخطاب للإدارة الأميركية الحاليّة – تضع ضمن أولوياتها استعادة النفوذ بالمفاصل الحيوية بمنطقة الشرق الأوسط، والقرب أكثر من حماية مصالح الحلفاء وبخاصة دول الخليج، ولجم تمدد إيران، والتعاون مع دول الاعتدال بغية الحرب على الإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي، هذه العناصر الكبرى لما يمكن أن ترسمه خطوط الالتقاء بين أميركا والحلفاء في ظلّ اضطرابٍ غير مسبوق أبرز أسبابه إهمال الأزمة السورية وحالة التثبيط التي صنعتها السياسة الخارجية الأميركية، هذا قبل أن يتدخّل الرئيس القوي والشجاع دونالد ترمب ليضع حداً للفظاعة الوحشية التي يمارسها النظام السوري على نحوٍ يندر مثيله عبر التاريخ، نظام يريد اختبار صبر الإدارة الجديدة، ويكاد يحفر قبره بيده.
أولى نتائج الضربة، دبيب الفزع إلى قلب النظام، إذ كتب مايكل إيفانز، بصحيفة «التايمز» البريطانية أن «حصانة الرئيس بشار الأسد وعائلته التي حكمت سوريا بقبضة حديدية منذ عام 1970، انتهت، وأنه سيكون عليه أن يعيش بلا هاتف خلوي بعيداً من عيون الأقمار الصناعية الأميركية. إن الأسد أدرك بعد الهجوم بصواريخ توماهوك الأميركية أنَّ حياته قد تكون مهددة من قبل الأميركيين، في الوقت الذي بدأ فيه المدعون العموميون في أوروبا بمصادرة ما قيمته عشرات ملايين الجنيهات من ممتلكات عمه». هذا برغم محاولة العناد ومقاومة الضربة باستمرار أساليب الوحشية واغتيال المدنيين الأبرياء.
إن ما يحتاجه العالم من ترمب أن يكون النقيض المطلق لباراك أوباما، على كل المستويات.
وإذا كان أوباما – كما يصفه فؤاد عجمي – بأنه صاحب «الخطّة الشريرة» لتسليم المنطقة لإيران؛ أوباما القائل عن رموز نظام إيران: «إنهم أصحاب فكر استراتيجي وليسوا مندفعين، ولديهم رؤية ويهتمون بمصالحهم ويستجيبون للتكاليف والفوائد، وهذا لا يدفع إلى القول بأنها ليست دولة دينية تعتنق جميع الأفكار التي أبغضها، ولكنها ليست كوريا الشمالية. إنها دولة كبيرة قوية ترى أنها طرف مهم على الساحة العالمية، ولا أعتقد أن لها هدفاً انتحارياً، ويمكن أن تستجيب للحوافز»، فإن ترمب وفريق إدارته على النقيض منه، إذ يعتبرون النظام الإيراني هو راعي الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وأساس «القاعدة»، وممر أسامة بن لادن، وأمين سر تنظيم داعش.
يعتبر عجمي أن أوباما هدد كثيراً ولم ينفذ أي قرارٍ عسكري عزم عليه، ما يهمّ به في المساء يتراجع عنه بالصباح مما جعل «سلطته موضعاً للسخرية، ومثلها سمعة أميركا في العالم، عندما هدّد بعواقب خطيرة للديكتاتورية السورية عقاباً لها على استخدامها السلاح الكيماوي، غير أنه لم يلبث أن تراجع واقترح تصويتاً في مجلسي الكونغرس على التحرك العسكري ضد سوريا»، ترمب هدد قليلاً، وفي آخر مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قبل الضربة لم يطرح حتى الخيار العسكري، غير أنه وبعد بضع ساعات كان مطر الصواريخ المشتعلة يدك مطار الشعيرات، أعيدت حينها عقارب الساعة ولن تعود المنطقة قبل الضربة كما هي بعدها، وبيان روسيا وإيران الأخير يوضح مستوى القلق، لقد عادت «أميركا الطبيعية» الأمّة التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي قوة القوى.
أميركا ليست مجرد بلدة سينمائية، بل هي موئل خلاصة القيم الغربية، ومن دون أدوارها لا يكتمل عقد النظام العالمي، وحين تنعزل ينكفئ العالم ويضطرب ويتلاطم، قدرها التاريخي والكوني أن تكون ضابطة إيقاع لكل الأحداث، وحين تبحر في خضم الأحداث تتراجع كل القوى. كان السياسي المخضرم هنري كيسنجر يأسى على منح أوباما الفرصة للروس لممارسة العبث المطلق بسوريا والمنطقة وهو الخبير بسلوكهم.
حضور أميركا بحضارتها وقيمها التي هي «قيم العصر» أفضل بالنسبة للعرب والمسلمين من حضاراتٍ أخرى مافياوية، خرافية، عدوانية، لا تمتلك قيماً تستحق التصدير.
إنه زمنٌ آخر، وتحوّل مشهود لتجاوز «سنين الانعزال».
أبريل
09
المسلمون بأوروبا… أسئلة الهوية وإخفاقات الخطاب
جريدة الشرق الأوسط 6 أبريل 2017
فهد سليمان الشقيران
تورد وسائل الإعلام الأوروبية بكافة نسخها بعض التجمعات لمسلمين مقيمين بها، يريدون تقييم التجربة الأوروبية، وربما يطمحون إلى تغيير نظامها، وإقامة النموذج الحاكم المنشود، مثال الحاكمية الإخوانية، أو الدولة القاعدية الزاحفة بعواصمها المؤقتة، أو الخلافة الإسلامية الداعشية. ويحدث أن يأتي صوتٌ إخواني مهجّن مثل طرح الدكتور طارق رمضان، الذي يعتبر الإسلام والمسلمين جزءاً من النسيج الأوروبي، وراح يناقش منذ زمن حول الهويّة، ودخل بحواراتٍ مطوّلة مع إدغار موران أشرت إليها أكثر من مرة في هذه الجريدة.
غير أن مشكلة الهويّة ليست بالاعتراف بوجود الآخر، بل احترام الغيرية الحضارية، وعدم التدخل بنسيج المجتمع موضع اللجوء، كما يحدث من بعض اللاجئين في ألمانيا؛ يريد بعضهم تعديل نظام الأمة نفسها، وهو الزائر، وهذا نابع من مركزية ضاغطة، واعتداد واهم بأن الآخرين بحاجة إلى ثقافتنا وتجربتنا وعقولنا، وإلى «تجربتنا الروحية»، التي لا حضور لها في التداول الديني الإسلامي، بل تغلب على المنابر أساليب غير مهذبة، وخطب القتل والتكفير والتدمير هي الأكثر حضوراً، وأي تجربة روحيّة تلك التي لم تهذّب ألسنة أولئك؟!
تلك النظرة الدونية للآخر الذي يلجأون إليه تعزز من حضور اليمين المتطرف ومن أحقيته بالفوز بفرنسا وألمانيا، ذلك أن فشل جميع تجارب تجديد الخطاب الإسلامي ودفعه نحو التحضر حرض اليمين على عزم خوض الحرب الشاملة ضد ذلك الخطاب وأذرعه وفروعه وتحطيم منابره. لقد جعل من المسلمين موضع إشكالٍ اجتماعي، هذا مع الفرص الكثيرة التي منحت طوال العقدين الماضيين لتحسين حضور الخطاب في المجتمع الأوروبي. في ظلّ كل الموجة اليمينية الضاغطة يأتي صوت وسطي ربما يشكل لبنة لبناء علاقة أكثر اعتدالاً بين المسلمين والأوروبيين، وبخاصة أفواج اللجوء الجديدة من مناطق الصراع في ليبيا وسوريا وغيرهما، إذ ذكر فولكر كاودر (السياسي البارز في حزب المستشارة الألمانية ميركل) أن «المسلمين جزء من ألمانيا وليس الإسلام جزءاً من ألمانيا»، وذلك خلال مقابلة مع DW، ويضيف: «إن حرية الاعتقاد هي أمر وجودي للحرية بحد ذاتها، ولا توجد حرية معتقد عندما تنعدم الحرية. إن حرية الاعتقاد هي أمر وجودي من أجل الحرية ذاتها، يصح مبدئياً لكل دين – وطبعاً في حدود القوانين والقانون الألماني الأساس. الإسلام دين يحصل على الحرية في بلدنا، لذلك يُسمح للمسلمين ببناء مساجدهم، ولكن لا يمكن بالطبع السماح في المساجد بتقديم أي شيء ضد ديمقراطيتنا وضد نظامنا الاجتماعي وضد».
يركز الطرح الأوروبي على ضرورة احترام القادم إلى دولهم للقيم والقوانين وتعلم اللغة، ذلك أن من عوائق التطوّر لبناء مجتمع مسلم منسجم مع الآخر عدم الدخول والاندماج والانصهار ضمن المجتمعات الأخرى، هذا مع احترام القوانين لهم وفسح المجال للشعائر، وإقامة المساجد، والأكل الحلال، وحرية التعبير.
طوال السنة الماضية قامت مؤسسات دينية حكومية بوضع ملاحق دينية بأنحاء العالم لغرض نشر الإسلام، ورفع مستوى الوعي، والقيام بأعمال الدعوة إلى الله، إلا أن الأحداث المتسارعة، ونمو التطرف، جعلا من طبيعة عملها موضع مساءلة، إذ تبيّن أن الأعمال التي تقوم بها روتينية، لم تعِ المشكلة الأساسية، ولم تدرك الخلل الثاوي في الخطاب، بل راحت تكرر الطروحات الجامدة، محاربة الرأي المخالف، ولم تفصل بين الخطاب الديني داخل المجتمع المسلم، وبين الطرح المنبري في المجتمعات الغربية بشكلٍ عام، مما عزز من تكوين صورة مسيئة عن الطرح الديني باعتباره – بالنسبة لهم – صانع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وسليمان أبو غيث وأبو حفص الموريتاني وأبو بكر البغدادي، وهذه القناعة لم ينجح جميع الدعاة المسلمين في تبديدها عن أذهان المتلقي الغربي، وتلك هي معضلة تجديد الخطاب الديني، مما جعل البعض يعتبره مستحيل التجديد بالشكل اللغوي المطروح، وإنما بالمنهاج العلمي التفكيكي والانثربولوجي والخروج التام من «السياجات الدوغمائية المغلقة» كما هو تعبير البروفسور محمد أركون، الذي أرّقه موضوع اللاجئين والهويّة والمسلمين منذ أيام الإرهاب بالجزائر الذي سبب نزوحاً إلى فرنسا، كما يروي في كتبه، وعلى الأخص في كتابيْه «من مانهاتن إلى بغداد» و«الإسلام، أوروبا، الغرب».
المرحلة تبيّن مستوى الصراع بين رؤيتين؛ الأولى (المسلمون جزء من أوروبا ليس الإسلام) والأخرى (الإسلام والمسلمون جزء من أوروبا)، صراع محتدم، ومعركة كسر عظم ستبدو نتائج الحسم بها في الانتخابات المقبلة بأوروبا، ولكن الأكيد أن الوضع الحالي بالنسبة للمسلمين لن يكون كما هو عليه سنين بحبوحة الترحاب منذ الهجرات الأولى وحتى النصف الأخير من القرن العشرين.
أبريل
09
مصائر «الأحقاد» لدى جيل ما بعد «الثورة»
جريدة الشرق الأوسط 30 مارس 2017
فهد سليمان الشقيران
بالصدفة، أرخيت سمعي إلى نقاشٍ بين فتاتين سوريتين على طاولةٍ مجاورةٍ بمقهى، الملامح توحي بأن عمرهما حين بدأت الأزمة لا يتجاوز الثلاث عشرة سنة، والحديث كلّه حول الحرب، ولا يخلو من نبراتٍ تشي بانبعاثٍ للهويّات القاتلة، وأوبة للأصول المذهبية، ووحشة شديدة من مشهد ليس له مثيل منذ سنين هتلر ولينين وستالين وصدام حسين، إحداهما تروي لزميلتها مشاهد مروّعة، ويبدو أنها رسمت وشماً في وجدانها، ونقشت على ذاكرتها صوراً لا تمحى.
هذه المحادثة تمثل جيلاً كاملاً، بفتيانه وفتياته، شبّ من الطفولة إلى الفتوّة بقنطرةٍ كان جسرها ملطّخاً بالدماء خلال السنوات الخمس الماضية، ولن يكون مسح آثارها سهلاً، إذ سيظلّ على الأقل مؤثراً بالأجيال الثلاثة القادمة، وهذا يذكّرنا بالدموية الكارثية التي حدثت بالحروب الكبرى، إذ شكّلت حالات الاغتصاب والقتل والتطهير العرقي أجيالاً من المقهورين الذين لن يكونوا خارج معادلة الانتقام، أو على الأقل التفكير به، أو الاكتفاء بالحسرة والندم.
إنه جيل الأقدار، يتكوّن ببطء على نارٍ من الارتكاسات الثقافية والدينية والسياسية.
شكّلت الحروب الأهلية الأوروبية الكارثية تاريخاً يحضر بوصفه عبرةً، وكانت مآلاتها اتجاه الحكماء لتأسيس أنظمة تتجاوز «حالة الطبيعة»، كما يعبّر توماس هوبز في كتابه «اللفياثان»، وهو معاصر للحرب الأهلية الإنجليزية، وهي حالة حرب الكل ضد الكل، وبذلك ينساق الجميع للحرب ضد الجميع، ضمن اقتناعٍ وبرودةِ أعصاب، ومع تأقلمٍ مع حالةِ الشرّ هذه، يغدو الدم جزءاً من الحركة السياسية والاجتماعية. ومن ثم، يحدث استمراء وإدمان لذلك، وإذا كانت الحروب الأهلية الإنجليزية والفرنسية والأميركية قد فقست عن مراحل أخرى سياسية، تمثّلت بأنظمة حكم مؤسسةٍ ابتدأت من «سيادة السلطان»، بوصفه سلطة السلطات، وطاعته من طاعة الله، كما يعبّر توماس هوبز، في القرن السابع عشر، فإن النظرية السياسية ستأخذ وقت نموّها الطبيعي لتتشكل ضمن «العقد الاجتماعي الحالي»، مع تعديلاتٍ وانتقاداتٍ مستمرّة له، منذ روسو إلى جون راولز، ذلك أن الواقع مثل الناس يتغيّر معهم، وبالتالي تزداد إنسانيتهم كلما كانت المؤسسات أكثر نضجاً، ولم يعد إمكان حربٍ أهليةٍ ببلدٍ عربي مثله ببلدٍ أوروبي، فالفرق بين تجربتين، وجمجمتين، وثقافتين، ولعل من أبرز خصائص التجربة الأوروبية أنها «متجاوزة»، وليست ارتكاسية جامدة، تجترّ التاريخ باستمرار بلا كلل أو ملل، ذلك الاجترار يؤسس للعنف، ويمنع المجتمعات من إدراك الحماقات التي تدفع لأجلها أرواحها ثمناً لها، إما لخرافاتٍ تاريخية، أو أكاذيب وأوهام موروثة لا أصل لها. تذكر الفيلسوفة الألمانية حنة أرندت، بكتابها المرجع «أسس التوتاليتارية»، ضمن تحليلها لحقبة النازية، ما يمكن الاستئناس به لتحليل جيل ما بعد ثورات الدم، ذلك أن الأثر الذي خلفته النازية يشبه آثار الحروب الحالية، وهي بكتابها وضمن فصل «مجتمع دون طبقات» ترى «أن افتتان الدهماء بالشر والجريمة افتتاناً أكيداً ليس بالأمر الجديد، إذ لطالما ثبت أن الرعاع يرحبون بأعمال العنف، قائلين بإعجاب: لئن كان ذلك غير جميل، فإنه بالغ القوّة بالتأكيد. على أن العامل الأهم في سيرورة التوتاليتارية، هو اللامبالاة الصادقة التي تلازم المنضوين في لوائها، لئن كان ممكناً أن يقدّر المرء عدم اهتزاز قناعات النازي أو البولشفي، حين ترتكب الجرائم في حقّ أناسٍ لا ينتمون إلى الحركة موضوع التآمر المزعوم، أو أن يكونوا أعداء لها، فإنه لمن المذهل ألا يرف له جفن حين يشرع الغول في افتراس أبنائه، وحين يصير هو نفسه ضحية الاضطهاد، وحتى في حال أنه أدين ظلماً، أو طرد من الحزب، وسِيق إلى الأشغال الشاقة، أو إلى معسكر اعتقال».
ثم تفصّل بتعبئة هتلر لـ«جيل الجبهة»، معتبرة أن «قلةً قليلة من ممثلي هذا الجيل أوتي لها الشفاء من حماستها حيال الحرب، إثر اختبار فظائعها اختباراً واقعياً، ذلك أن الناجين من حرب الخنادق لم يصيروا دعاة سلام، إنما آثروا نوعاً من الاختيار من شأنه أن يفصلهم على حد اعتقادهم فصلاً نهائياً عن محيط (الكرامة الكريه)، والأحرى أنهم مضوا يتعلّقون بذكريات السنوات الأربع التي عاشوها في الخنادق، كما لو أنها شكّلت معياراً موضوعياً من أجل تأسيس نخبةٍ جديدة».
الجيل الذي عاش الفظائع في العراق، وليبيا، وسوريا، لن يكون بمنأى عن آثار الحرب، ذلك أنها ليست حربًا طبيعية مؤسسة ومنظّمةً ذات هدفٍ محدد، بل ضمن آثار انتفاضات دخل فيها الديني والطائفي والعرقي والقبلي، كل الانتماءات والنزعات أوقظت، وتحال إليها كل المعايير المسببة لضغط الزناد وقتل الآخر القريب، ذلك أن الجيل الغضّ الناشئ والنابت حديثاً قد تهشّم مبكراً، لقد رأى جيل بأكمله كل ما يمكن أن يقوم به الإنسان من شرّ، وعلى الجميع تهيئة المستقبل لأخطار سترتدّ على العالم من جيل غضّ منكوب، وجيل المقاتلين الذين يصعب إدماجهم مستقبلاً بالحياة المدنيّة.
حنة أرندت، وبمعرض مقارنتها بين الثورتين الأميركية والفرنسية، بكتابها «في الثورة»، تكتب ناعيةً البشر، وهم محتوى ماكينة الثورة التي تفرمهم: «إن جماهير الفقراء، هذه الأغلبية الساحقة من البشر، الذين سمّتهم الثورة بالبؤساء، والذين حوّلتهم إلى غاضبين، تخلّت عنهم، وتركتهم يحملون الضرورة التي خضعوا لها منذ القدم مع العنف، الذي استخدم دائماً للتغلب عليها، إن الضرورة والعنف كلاهما جعل البؤساء لا يقاومون قوّة الأرض».
التاريخ لا يعيد نفسه، غير أن التجارب مثل البشر قد تتشابه.