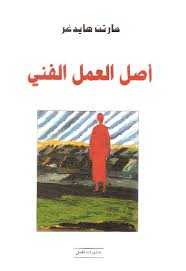سبتمبر
22
الفنون والحروب.. صراع التذكّر والنسيان
فهد بن سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 22 سبتمبر 2016
يبدو أنّ الفنان محمد عبده لم يستطع كبح جماح غضبه؛ في ختام حفلته بدبي إذ صاح بالجماهير: «نلتقي في الوطن، لا نريد الفنّ أن يكون في المنفى»، قبلها بأسابيع أحيا حفلةً يتيمة بسوق عكاظ، ومن ثم شاع الحديث عن تأجيل حفلتين له قيل إن السبب يعود إلى موسم الحج. حين يبحر الفنّ ضمن ثقافة يتصل فيها كل شيء ولا ينفصل عن أي شيء، بحيث لا تستطيع إدراك الحدود بين الدين والفن والسياسة يتحوّل الفن إلى ضحية. منذ أوائل عام 2010 والحركة الفنيّة السعودية تعاني من تراجعٍ مخيف، وذلك بسبب البعد السياسي؛ إذ أجلت برامج فنية كثيرة بسبب ما يجري للآخرين في بلدانهم من اضطرابات سببتها التظاهرات، وتبعها الحدث السوري الدموي، والآن يربط البعض بين معركتنا الكبرى ضد المتمردين في اليمن وبين المهرجانات الفنيّة، بينما نستطيع أن نحتفل بالفنون، ونخلّد بالشعر والموسيقى أمجاد أولئك الأبطال وهم يرابطون على الثغور.
ترسم الفنون وشومًا خالدةً على جسد المجتمع، ذلك أنها محتوى للذاكرة، وفضاء للتعبير عن الوجود، وأجلّ وأغمض ما يتركه الفنّ هو «الأثر»، يصف ذلك فيلسوف له مغامراته في محاولات القبض على جوهر الفنون وهو مارتن هيدغر في كتابه «أصل العمل الفني» حين يكتب: «إن ما يتميز به الجمال لا يمكن معرفته بصفته وصفًا محددًا معينًا، يمكن إدراكه في شيء من الأشياء، وإنما يتعيّن وجوده عن طريق شيءٍ ذاتي، تزايد الحسّ الحياتي في التطابق المتناسق بين المخيلة والعقل، إنه بعث حياة في كل قوانا الفكرية، ولعبها الحر، الذي نعيش تجربته في جمال الطبيعة والفن، الحكم الذوقي ليس معرفةً، ومع ذلك فهو ليس شيئًا كما اتفق، فهناك حق عمومي يمكن أن تشيد عليه استقلالية الميدان الجمالي». ثم يشير إلى كون الفن فعل مقاومة لتفاهة الحياة، لأن عمق الفن في كونه إجراء نظرة أخرى على الوجود، ذلك أن أثر وقع الفن يوشك أن يكون حدثًا يشبه الصراع بين العالم والأرض.
والفنّ يكتنز من الذاكرة ما أوشك على النسيان، بل يغدو مستودع ما ينساه البشر، إذ إن الثيمات والعلامات والمقامات هي خلاصة تجارب الأمم مع الحقيقة والوجود والواقع، كلها تنشّأت ضمن مجالات الحرث في الأرض والطبيعة، لتغدو ذاكرة المجتمع مشتتةً موزعةً بين النوتات والمقامات والمجسات والمواويل، هنا يأتي دور النسيان المجتمعي في بناء الأثر الفني.
كل إبداعٍ فني يأتي بعد نسيان لأتذكر بعده، واليقظة التي تسري في الوجدان حين نخالط الآثار الفنية هي شكل الرغبة في إدراك جوهر الفن، الذي لا جوهر ملموسًا له.
حنة آرندت، الفيلسوفة القريبة من وجدان هيدغر ومن قلبه، كتبت مطوّرةً في الأثر الهيدغري الفني، في مؤلفها المهم «الوضع البشري»: «إن هذا القرب من الذكرى الحيّة هو الذي يمكن الشاعر من البقاء ومن الحفاظ على ديمومته خارج الصفحة المطبوعة أو المكتوبة، ورغم أن كيفية قصيدةٍ ما يمكن أن تكون خاضعةً لتنوعٍ كبير من المعايير، فإن (قابليّة الاستذكار) ستحدد بالضرورة استدامتها؛ أي فرصتها في أن تكون دائمًا مرتكزةً في ذكرى البشرية… فإن القصيدة نفسها مهما طال زمن وجودها باعتبارها كلامًا حيًّا في ذكرى الشعر وجمهوره سيكون من الممكن واقعًا أن تتحول إلى شيءٍ ملموس من بين الأشياء، لأن الذاكرة التي وهبت الذكرى التي تتولد عنها الرغبة في الخلود تحتاج إلى أشياء ملموسة لتتذكّر».
تحدّثت عن القصيدة بوصفها أثرًا فنيًا، وكذلك الأمر يجري على كل أصناف الفنون، فنسيان علل الفن وجذره يحقق الدهشة التذكّرية لحظة التذوّق والمرتبط برغبةٍ مستحيلة للتذكر، غير أن الفن يسارع بحراسة النسيان، لأنه ليس معرفةً أو حقيقةً، بل خلاصة آثار ذاكرية منسيّة إلى الأبد.
يأخذ الفنّ مساره الحي حين يتم فهمه، لا بوصفه انغماسًا في شيئية الحياة وفراغها، ولا بتفاهة المنتج، أو عشوائية السلوك الجماهيري الحاضر للمناسبة، بل بوصفه فضاء من الجمل والرموز والأصوات الخالدة المرتبطة بالمجتمع، بل شهد الفنّ طفراتٍ فنيّة عظيمة في أوقات الحروب والأزمات في أوروبا، كان الفن مزدهرًا في أتعس الأوقات وأصعبها، ذلك أنه شريك في الوصف والرسم، وله دوره في تقوية المجتمع حين يمرّ بأوقاتٍ سياسية صعبة، يأتي ذلك فقط حين نجيد فهم الفنّ، متجاوزين التهريج والتفاهة، حينها لا نحتاج لتبرير الحفلات الفنيّة بمنطقٍ سياسي، وبخاصة وأن القيادة السعودية أسست معهدًا ملكيًا للفنون والموسيقى، ومهمته الاعتناء برقي الفن والصعود به من الهواية المحضة إلى التعلّم الأكاديمي المنظّم.
حالات «نفي الفن» التي تحدّث عنها محمد عبده لم تكن لتحدث لو أن هناك حدود مفهومة تقي المجالات المتعددة من الاتصال المعثّر، ولا بد من فصل الفنّ عن المجالات الأخرى، وتنقيته وفصله عن الأمور الأخرى، إذ لا مبرر منطقيًا على الإطلاق أن توقف الحفلات الفنيّة؛ لأنها جزء صميم من وجود الفرد، بل يحدث أن ينتعش في حقب الصراع، وعلى حدّ وصف هيدغر: «فإن العمل الفني يرتكز إلى فعالية النزاع بين العالم والأرض».
سبتمبر
22
الحضور الفني بالعمل الدبلوماسي
فهد بن سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 8 سبتمبر 2016
في عام 1985 زار الملك فهد بن عبدالعزيز الولايات المتحدة للمرة الأولى بعد توليه للحكم، كان الاستقبال حاشداً. وحدث أن ألقى الرئيس الأميركي ريغان كلمته بعشاءٍ تكريمي للملك بالبيت الأبيض، ولأن الخطاب تضمّن مستوى بعيداً وصعباً من الحثّ على ترتيب العلاقة بين العرب وإسرائيل، فقد قرر الملك أن لا يرد على ريغان، وأن لا يلقي كلمته الجاهزة بين يديه بل ارتجل حديثاً استمر نصف ساعة عن الرياضة في السعودية فالمنتخب حينها له جولاته بحصد البطولات. كان خطاباً ذكياً سار بالمناسبة إلى برّ الأمان، إذ كان الاصطدام وارداً في تلك اللحظات بسبب اختلاف المواقف حول مبادرة السلام التي طرحها الملك آنذاك. بعد العشاء صحب الملك ريغان إلى قاعة أخرى فيها فرقة موسيقية وعلى المسرح فتاة تغني الـ”أوبرا” بصوتٍ صافٍ وكان هائماً جذلاً وهو يستمع للعمل الفني البديع.
تلعب الفنون بأنواعها أدوارها السياسية والديبلوماسية.
في زيارته للصين أهدى الأمير محمد بن سلمان لوحة “طريق الحرير” الفنّية من إبداع الفنان أحمد ماطر للرئيس الصيني٬ كانت رسالة ديبلوماسية بليغة لأمة الصين. والأمير سعود الفيصل استثمر ديبلوماسياً قصة تعلق كوندليزا رايس بالموسيقى والسينما٬ ونجح في تتبع ذوقها٬ وأهداها بضع اسطوانات في إحدى المناسبات٬ السمراء الأنيقة التي درست الفرنسية وتعلمت “الإتيكيت” هي أيضاً عازفة بيانو جيدة٬ لديها تعلق شديد بموتزارت منذ الصغر٬ تقول: “عزف الموسيقى في الغرفة المخصصة للعزف يساعد كثيراً على الاسترخاء على الرغم من أن الأمر ليس سهلاً عندما تعزف مقطوعات لمشاهير الموسيقيين… وعندما أعزف أشعر بأنني بعيدة عن نفسي٬ أشعر بأنني كنز … أعشق برامز لأن موسيقى برامز متينة البنيان٬ وتعبر عن مشاعر عميقة دون إغراق. لا أحب الموسيقى المغرقة في المشاعر٬ وبالتالي لا أميل لموسيقى مثل موسيقى ليست٬ ولا أعبأ في الواقع كثيرا بالموسيقيين الرومانسيين الروس مثل تشايكوفسكي ورخمانينوف٬ حيث التركيز على غلاف الأسطوانة أكثر من المحتوى. موسيقى برامز متقنة وتبقي على حالة من التوتر لا تنتهي“.
ديبلوماسية الفنون حضرت بأحاديث وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي٬ الذي تحدّث من طوكيو عن الموسيقى وأكاديمية الفنون الملكية٬ والتقدم الموسيقي في اليابان٬ وهو يحاورهم قال: “أنا من محبي الموسيقى الكلاسيكية وأوبرا “برامز” هي ربما أفضل مَؤلَّفة موسيقية على الإطلاق٬ وأنا أستمع إليهم جميعا٬ لكن كونشرتو البيانو رقم 2 هو العمل الموسيقي المفضل بالنسبة إلي٬ خاصة حين أعاد تقديمه المؤلف الموسيقي النمساوي كارايان في ستينات القرن الماضي٬ وأعتقد أنه يحظى بشهرة واسعة في اليابان٬ وأود أن أشاهد يوماً ما شاباً سعودياً يمكنه العزف على آلة (التشيلو) على الصعيد العالمي٬ كما الفنان الشهير يويو ما“.
تعبّد الصيغ الفنية ما تعجز عنه السياسة٬ بل وتؤسس لمشاريع سياسية مشتركة٬ التقارب الإيراني الأميركي الأخير بدأ من أحاديث فنية٬ ففي أواخر عام 2009 شهدت “لاهاي” مؤتمراً حول أفغانستان حضره الديبلوماسي الأميركي ريتشارد هولبروك ومستشاره والي نصر٬ خلال الاستراحة وبينما كان كل المشاركين يتحلّقون حول القهوة والأطعمة البسيطة٬ توجه هولبروك إلى رئيس الوفد الإيراني مهدي أخوند زاده وكان حينها نائباً لوزير الخارجية وتحدّث معه طوال مدة الاستراحة فقط عن معرض زاره حول الفنون الآسيوية مبدياً إعجابه ببعض المعروضات الإيرانية التي تعود إلى عصر المملكة الصفوية الإيرانية٬ واكتفى مهدي زاده بالابتسامة وإيماءات الرضا٬ اتضح حينها لدى مساعدي هولبروك أن إدارة أوباما قد عزمت على المفاوضات الجادة مع إيران.
في كتاب “تاريخ الدبلوماسية” المهم لـجريمي بلاك٬ أورد تاريخ ارتباط الفنون بالعمل الدبلوماسي وبالفصل المخصص للقرن السابع عشر٬ يذكر كيف: “أدى الفن دوراً كبيراً للسياسة٬ فقد اشترى مبعوث إمارة هيس كاسل في لندن رسوماً لأميرها في منتصف القرن الثامن عشر٬ وكذلك تلسكوب جيب صغير٬ واستخدمت كاترين العظمى ملكة روسيا دبلوماسييها لاقتناء أعماٍل فنية٬ أبرزها مجموعة هاوتون من بريطانيا٬ وكان من المتوقع أيضاً من الدبلوماسيين شراء أعمال فنية لأفراد بارزين غير صاحب السيادة”. ثم يضرب مثلاً بدور “بيتر بول روبنز” الرسام الشهير في تنقية الأجواء السياسية في العلاقات الإنجليزية٬ الإسبانية٬ وذلك في أوائل القرن السابع عشر٬ حيث أدى الفنان دوراً دبلوماسياً بارعاً.
للفنون والثقافات دورها في تذويب الرؤى الصلبة في العمل السياسي. والديبلوماسية المحتمية بالفنون والمتسلحة بالثقافة تستطيع اختراق المجتمعات وسَحْر القادة٬ وهي بذلك تبدي احتراماً للبلدان والأمم والشعوب٬ ذلك أن كسب التحالفات مع الدول والقوى لا يكون من دون إبداء الوعي بالمجتمع المراد زيارته أو التواصل معه٬ فلكل مجتمع تاريخه ورموزه وأساطيره٬ والساسة الكبار يقضون وقتاً يتحدّثون به مع ساسة آخرين خارج الموضوع السياسي. هنا يدخل الفن مؤدياً دوراً ديبلوماسياً يفكك من خلاله المستغلقات٬ ويحسّن من إمكانات التفاوض؛ وعلى حد تعبير جريمي بلاك في كتابه آنف الذكر: “الديبلوماسية هي لعبة ترتكز على صناعة التحالفات٬ وهي جزء من لعبة الحرب٬ أو على الأقل لعبة استخدام القوة٬ والتفاوض يضاعف القوة٬ وليس أداة لتجنب الصراع“.
سبتمبر
22
الأمير في «الصين».. «الرؤية على طريق الحرير»!
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 6 سبتمبر 2016
تعبّر الزيارة الأميرية إلى الشرق عن انفتاحٍ أكثر جدية مع تلك القوى الاقتصادية والسياسية، وتبرهن على حيوية الأمير محمد بن سلمان مع الدول الكبرى، بغية صناعة الرؤية المزمعة في السعودية، وتهيئة الأجواء الاقتصادية لها، وفي الوقت نفسه بحث المسائل السياسية الحساسة في المنطقة مع بكين. والمتابع لتطوّرات نموّ العلاقة بين البلدين منذ منتصف الثمانينات لا يصدّق أن ذلك البطء في تدشين العلاقات بين البلدين يمكنه أن يتحوّل إلى تعاونٍ متسارع مطّرد في تميّزه. اللقاء الأول بين الدولتين كان في عمان في نوفمبر (تشرين الثاني) 1985، حدث تعاون عسكري بين الصين والسعودية حتى قبل أن يتم تبادل السفارات في عام 1990، تعاون عسكري سبق هذا التاريخ بسبب الحرب العراقية – الإيرانية، حين بعث الملك فهد – رحمه الله – وفدًا بمهمّة سريّة تقضي بشراء صواريخ أرض أرض، ساهمت في تغيير ميزان القوى في المنطقة، وهي صفقة أخفتها السعودية حتى عن الولايات المتحدة، التي لم تكتشف وجود الصواريخ الصينية في السعودية إلا بعد سنتين.
استطاعت السعودية أن تتعاون مع الصين قبل أن تكون لديها علاقات رسمية معها، بل كانت لديها علاقة دبلوماسية مع تايوان، غير أن بدء التمثيل الدبلوماسي أوائل التسعينات جعل المملكة شريكًا اقتصاديًا للصين بشكلٍ فريدٍ على مستوى الشرق الأوسط. الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان تمركزت أهميتها في ملامح كثيرة:
أولها: أهمية التعاون الذي أثمر خمس عشرة اتفاقية بين البلدين، في مجالات متعددة من أبرزها الطاقة، وتخزين الزيوت، ومجالات التعدين والتجارة. كذلك تم توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان السعودية لإنشاء مدينة جديدة في ضاحية الأصفر، واتفاقية لتنمية طريق الحرير المعلوماتي، ومذكرة تفاهم بين وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للتعاون في المجال العلمي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية. كما تم توقيع اتفاقات اقتصادية مع القطاع الخاص في الصين، أبرزها اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومركز تنمية التجارة الدولية الصينية، وجميعها تخلق بيئة داعمة للرؤية في السعودية.
ثانيها: أن الزيارة أخذت أهميتها من خلال القمم التي عقدها الأمير محمد بن سلمان مع زعماء العالم، وذلك للبحث في موضوع النفط، والأزمة السورية، والاضطرابات في المنطقة، وسبل إطفاء الحرائق المشتعلة ضمن اتفاقياتٍ عميقة ودائمة تدعمها الدول الكبرى. يضع الأمير موقف السعودية بين زعماء العالم للبحث في أسسٍ تدعم الحل السياسي في سوريا من دون تبديد مصالح المجتمع السوري، أو إنقاذ لرئيس النظام البعثي، بل للبحث في تسوية أممية تحفظ استحقاقات السوريين وتصنع لهم مستقبلاً يليق بالتضحيات التي قدموها طوال السنوات الخمس الماضية، والرئيس بوتين عبّر عن استحالة وجود اتفاقٍ إقليمي من دون حضورٍ سعودي، هذا صحيح، لكن لا يمكن للسعودية أن تكون منساقة خلف السيناريو الروسي الإيراني الذي يرسم لوضع مستقبلٍ محدد مسبقًا في سوريا.
ثالثها: الجانب الاستراتيجي للزيارة، وقد عبّر عنه وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، الذي قال: «إن المساعي الصينية لإحياء طريق الحرير لربط شرق الكرة الأرضية بغربها، تنسجم مع (رؤية السعودية 2030)؛ ذلك أن الرؤية سترتكز على تحويل الموقع الاستراتيجي للمملكة بين الممرات المائية العالمية الرئيسية، إلى مركز لوجيستي عالمي، والصين وهي الشريك التجاري الأول للسعودية، ستستفيد من الشراكة مع المملكة، في استقطاب فرص استثمارية واعدة خدماتية أو لوجيستية أو في قطاعات الأعمال التجارية والصناعية المختلفة».
الخبير في الشؤون الآسيوية، البروفسور عبد الله المدني، كتب ملفًا مهمًا عن هذه الزيارة، رأى أن العلاقات السعودية الصينية سترقى إلى مستوياتٍ أعلى: «ما دام أن الضيف الزائر الأمير محمد يقود اليوم مشروعًا غير مسبوق لتنويع اقتصاد بلده ووضعه على طريق الأمم الصاعدة، وما دام أن الصين لديها أيضًا مشروع (طريق الحرير) الذي أطلقته في عام 2013 تحت اسم مبادرة (حزام واحد، طريق واحد)، بهدف تمكين منشآتها وشركاتها العامة والخاصة من الاستثمار والعمل في 65 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط من تلك الواقعة على هذا المسار، بل وأسست لهذا الغرض (صندوق الحرير) برأسمال 40 مليار دولار، إضافة إلى تأسيسها للبنك الآسيوي للاستثمار برأسمال 500 مليار دولار».
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمير محمد بن سلمان بقوله: «إنه شخصٌ يعرف جيدًا ما يريد تحقيقه، ويعرف كيف يحقق أهدافه، وفي الوقت نفسه أعتبره شريكًا موثوقًا يمكن أن نتفق معه وأن نكون واثقين من تنفيذ تلك الاتفاقيات».
تلك خلاصة حركة الأمير المتّقدة التي لن تهدأ إلا برؤية الرؤى وقد صارت واقعًا ملموسًا على الأرض.