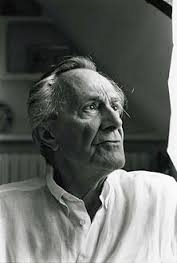فبراير
23
سجالات القطيعة والتراث بين رضوان السيد وعلي حرب
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 23 فبراير 2017
بعد حادثة تكفير نصر حامد أبو زيد، والجلبة التي صحبتها في النصف الأول من التسعينات، استضافت جيزيل خوري، ضمن برنامجها «حوار العمر»، الدكتور نصر، وزوجته ابتهال يونس، ورضوان السيد، وتضمن البرنامج مداخلةً من علي حرب.
رؤية رضوان أن الكتاب سبب التكفير «نقد الخطاب الديني» كان بالأساس نقدًا سياسيًا، بينما علي حرب يعتبره مدخلاً للنقد الواسع الذي لا يبقي ولا يذر، وهذان الرأيان يعبران عن تمايز بين مشروعين، بل واختلاف عميق بين رؤيتين يمكن الاستئناس باستعادة بعض عناوينهما للإضاءة والتحليل.
رضوان السيد شيخ أزهري وناقد للخطاب الإسلامي من داخله بغية تطويره وتجديده، يؤكد دور الحكم الصالح والرشيد في إزالة ما علق بالتراث من أوضار أعاقت حركة المسلمين، انشغل بالأمة والجماعة والسلطة، وسياسات الإسلام المعاصر، والتفكير بالدولة في المجال الإسلامي… حارب دعاة القطيعة مع التراث، واعتبر مفكري القطائع يحاربون العروبة والإسلام، بينما حرب على النقيض تمامًا؛ أخذته الفلسفات المنبثقة الصاعدة بفرنسا، خصوصًا فلاسفة الاختلاف، منذ نيتشه وصولاً إلى دريدا وفوكو ودلوز، وقد تطوّرت رؤيته «ما بعد الحداثية» من «التأويل والحقيقة»، كتابه الذي أحال فيه بالهوامش مرارًا على رضوان السيد، وصولاً إلى «نقد النص – نقد الحقيقة – الممنوع والممتنع»، وليس انتهاءً بـ«ما بعد التفكيك»، وتأثر كثيرًا في تطبيقاته بجاك دريدا، بينما في كتابه «نحو منطق تحويلي» نعثر على انهماك بنصوص جيل دلوز، وهو يطرح الآن، كما في مقالته الأخيرة بجريدة «الحياة»، مفهوم «ما بعد الحقيقة»… اختلاف جذري، ما يجمع بينهما فقط تشابه الرؤية للنموذج اللبناني المراد، إذ كلاهما من المؤيدين لمشروع ما كان يعرف بالرابع عشر من آذار (مارس) بلبنان.
في مقالةٍ مطوَّلة نشرها علي حرب بجريدة «الحياة»: «صادق جلال العظم الأكثر تنويرًا والأقل نرجسية»، مرر بعض اختلافه مع المشروع الذي يمثله رضوان السيد، ومما كتبه: «إذا شئنا المراجعة والمحاسبة، لاستخلاص الدرس، لا مهرب من إعادة النظر فيما طرح من شعارات وبرامج. ليس هذا فحسب، بل أيضًا إعادة النظر فيما تُدار به الشعارات والقضايا والهويات من طرق وأساليب وخطط. وآية ذلك أن الشعار ليس ما نطرحه ونسعى إلى تطبيقه بحرفيته، لكي ننتهكه أو ندوس عليه، إذا لم ننجح في تحويله على نحو مثمر وبنّاء، وعلى ما تشهد التجارب المريرة والمآلات البائسة للشعارات والمشاريع… وتلك هي اللعبة والرهان: مجابهة ما يقع ويفاجئ، بخلق وقائع جديدة تسفر عن تغيير الخرائط والمعادلات وسط المشهد، وعلى المسرح، وتلك هي قضية (ما بعد الحقيقة) التي فيها يتجادلون اليوم ومنها يفزعون… فأكثرنا كان يحركه فيما يكتب ليس حب الحقيقة، بل جوع عتيق إلى الشهرة والمنصب، أو إلى الجائزة التي باتت تشكل هاجسًا لدى كثيرين من العاملين في القطاع الثقافي».
بينما في حوار أجريتُه مع الدكتور رضوان السيد نُشِر بموقع «العربية»، هاجم مشاريع «القطيعة» التي يُعدّ علي حرب من أقطابها بالمجال العربي، بل اعتبره طه عبد الرحمن من أكثر ناشري ومطبقي مفهوم «التفكيك» عربيًا، وبمعرض هجوم رضوان على أولئك، حكى مستغربًا: «قرأتُ قبل أيام كتابًا عن (مفكري القطيعة) العرب. هؤلاء الناس لا يشكون من الجهل أو سوء النية، بل من دوغمائيات بشأن التقدم وشروطه. وهم ينسبون جزءًا وازنًا من تخلفنا إلى عشعشة ذلك الموروث في عقولنا ونفوسنا. وقد كان كثير منهم مغرَمين بفوكو مفكر القطيعة، وأرادوا أن يكونوا كبارًا مثله. وقد رحّب بكتاباتهم كثيرون من شبابنا وكهولنا، لأنهم منزعجون من الأحوال السائدة في التقاليد الدينية، وفي الأنظمة التسلطية. الطريف أنه دافع عني وقتها الأستاذ الدكتور ولد أباه، وهو يعرف فوكو أكثر منهم، لأن أُطروحته للدكتوراه في الفلسفة الحديثة عن فوكو. ومع ذلك فهو لم يغترّ بقطائعه، ولم يفهمها كما فهمها المدرسيون العرب».
هذا الاختلاف بين المشروعين، رغم ما يمثله من عنصر غنى للقارئ العربي، يبرهن على ارتباك الرؤية الفكرية للخروج من الأزمات الفكرية والسياسية والدينية بمجالنا الإسلامي، بين «الاتصال والانفصال» مع التراث، على طريقة رضوان السيد، و«القطيعة» ونقد الحقيقة وتجاوز كل الموروث ونقده وفضحه وكشفه على طريقة علي حرب، تبدو مسافة كبرى بين المشروعين؛ رؤية من الداخل تكتسب النور مما هو مضيء داخل التراث، وأخرى تعتبر العالم سائلاً بثقافاته، متداخلاً بمؤثراته وتداولاته، كما هو شرح «العقل التداولي» لدى حرب.
كل المشاريع المتاحة والمتداولة والمتساجلة على الساحة تشكل عناصر ثراء وغنى، بها ترتفع الصيغة الفكرية، وتغتني المفاهيم والأساليب الحوارية، وربما تتكامل بالأثر الذي تتركه وتحفره، خصوصًا للطلاب والمتعلمين، إذ يرتفع مستوى أحكامهم حتى يقرروا الاختبار لاحقًا بين الصروح العلمية، والمدارس التحليلية، والمناهج الفلسفية، وهذه سنة العلم، إذ لا يمكن أن تلغى الفلسفات والمعارف والمناهج، ولا أن تهمش أو تقزم مهما كانت أساليب الهجوم عليها، لحسن الحظ أن وصلنا إلى هذا المستوى من التفجر العلمي العربي المفيد والمضيء والمغني للدراسات والعلوم والمعارف التي تغتني من بعضها، حتى وإن نفت ذلك، أو لم تعترف به، كما أثرت أسئلة الفلسفة المثالية على أنبجاس «الهدم الجينالوجي» لدى نيتشه.
نعيم الفكر في سجاله وآثاره، وقديمًا قال ديكارت واصفًا رحلة الخروج وقلق السؤال ومشقة المسير: «فكأني سقطت على حين غرة في ماء عميق جدًا، فراعني الأمر كثيرًا، بحيث لا أستطيع تثبيت قدميَّ في القعر، ولا العوم لإبقاء جسمي على سطح الماء».
فبراير
23
«التفاهة» باغتباط… وأسرار الامتلاء الغامض
فهد سليمان الشقيران
جريدة الشرق الأوسط 9 فبراير 2017
مرّ زمن كانت به التفاهة عبارة عن فشل في تأويل ما هو رصين إما لضعف في الاستتباع، أو لجهل بالمعنى، أو لرغبة خالصة بأن تحول الأمور الجادة إلى حالة من التفاهة. منذ صرعة الأجهزة الذكية واللوحية وبعض المنبهرين بها من أدباء وكتاب يستلذ بإنهاء دور المثقف، باعتبار الشعبي قد «برز» وأخذ مساحته، وصار له منبره، على طريقة الإعلامي الجماهيري الشعبوي «منبر من لا منبر له»، لكن مشكلة التفاهة السوشلية أنها ليست نسخة تالفة من نصٍ جاد، كما في موجة الشبان الوجوديين في فرنسا بعد تحول «السارترية» إلى موضة، اختصرت حينها بنوع لباس، وطريقة شعر، وفلتان سلوك، وصارت على الأرصفة مشاهد الشبان والفتيات مجرد أزياء تافهة ولا قيمة لها، ولا تعبر عن الفلسفة الوجودية بكل نسخها «المسيحية» كما لدى كيركغارد وغابريال مارسيل، أو اللادينية لدى هيدغر وسارتر، لقد كان تمردًا مراهقًا استخدمت بعض أفكار الوجودية فيه، لكنهم على المستوى الفكري يمارسون التفاهات، ولا يستطيعون العيش إلا بالتفاهات.
الظاهرة السوشلية غلبت الجميع، طوفان جارف، هجاؤها لن يخفف من زعقها، وأصعب المباحث أن تحاول تأصيل جذر التفاهة، أو البحث عن سببه وعلته، قد يبدو الحديث عن كون تلك الظاهرة من جملة ما أتت به انهيار المراكز وتفتت المراجع، وعودة كل شخصٍ إلى ظلّه يعطيها عمقًا أكثر مما تستحقه، لكن يمكن تناول إشكالياتها على مستويين؛ الأول: الصعود التقني، والصرعة التكنولوجية، وهذه بدت بواكيرها منذ أن انبهر العالم بـ«القنبلة الذرية»، حينها راح فيلسوف مثل هيدغر يبحث بهذه التقنية الصانعة، وسماها «ميتافيزقيا العصر»، واستمرت مراقبة هذا الزحف المهول باعتباره يجعل الإنسان تابعًا لها، من هنا وضع هيدغر مقالته عام 1953 تحت عنوان «مسألة التقنية»، وبها كتب: «إنني أحاول أن أفهم ماهية التقنية»، وفي جواب آخر له يرى «في ماهية التقنية الظهور الأول لسر أكثر عمقًا بكثير» يسميه «الحدوث» ويشرح: «يمكنكم أن تفهموا أنه لا مجال للحديث عن مقاومة أو إدانة للتقنية ولكن الأمر يتعلق بفهم ماهية التقنية والعالم التقني».
مفهوم آخر طرحه فرنسوا ليوتار بكتابٍ كان امتدادًا لفكرة «التقويض» الهيدغرية، أطلق عليه ليوتار «ما بعد الحداثي» كبرت كرة الثلج هذه، وفتحت سجالات «التجاوز» للحداثة، على مستوى الفنون، والعمارة، والفلسفة، والأدب، وسواها، والنقاش حول التقنية وتفجراتها وارتباطاتها بالرأسمالية أو الحدود والثقافات والمراكز كان مطروحًا. وقد استفاض بذلك الفيلسوف المناوئ لليوتار وهو هابرماس بكتابه «العلم والتقنية كآيديولوجيا». وبرغم النقد المنطلق من أرضية اشتراكيته فإن تيري إيغلتون لم يخطئ الوصف حين اعتبر الحداثة الصاعدة والبعدية مما تحفر له نقض العمق، والمراكز، والجذور، والأسس، وهي «فن استبطاني، متأمل لذاته، واشتقاقي وانتقائي وتعددي، يميع الحدود بين الثقافة الرفيعة، والثقافة الشعبية، كما يميع الحدود بين الفن والتجربة اليومية». ذلكم هو المستوى الأول، بالتأكيد أن التقنية ظاهرة تأتي ضمن انفجارات واشتعالات في الصناعة والطبابة والعلوم الإنسانية.
أما المستوى الآخر، وهو الأكثر إلحاحًا على التشخيص، فهو المستخدم، أو الممتطي للتقنية، وقد أثمرت تلك الصرعة السوشلية عن أشخاصٍ يجيدون التثقيف والحديث، ولهم مسارهم العلمي أحيانًا، وقد يكون ذلك مفيدًا، غير أن النقد سأصبه على «النجوم التافهين»، الصاعدين على هذه المنابر، طارحين أنفسهم قدوات للأجيال الحالية الحيّة، والأجيال التي ستأتي لاحقًا بعد قرونٍ من الزمان. أولئك ينبتون كالكمأة بلا جذرٍ ولا أس، ويغتبطون بالتوجيه والحديث بتوافه الأمور، ويغترون بالجلبة المحيطة بهم من أناسٍ تافهين مثلهم، وأنتجت الظاهرة السوشلية قلة الأدب، وتعميم الشتيمة، والعبث بأخلاق المجتمع، وتطرح للأسف هذه الأسماء بالمنابر والنوافذ على أنها تحمل قيمًا معينة، والواقع أنها حالة تجهيل منظّم، فعزف الطلاب حتى عن كتبهم المدرسية، وصارت السوشلة إدمانًا ومرضًا، وفجرت التقنية تلك عن دمامات في الذوات، وانبهار بالشخصية من دون مبررات حقيقية علمية أو عملية، هذه ظاهرة لا يمكن تشخيصها إلا بوصفها «تفاهة» والتفاهة ليست شتيمة بل وصف محايد مؤدب للأشخاص الذين يتدخلون بما لا يعرفون، وفي المعاجم أن التافه مشتق من «تفه» و«تفه الطعام أي صار بلا طعمٍ أو ذوق»، وفي الحديث النبوي وصف الرويبضة بأنه «التافه الذي يتكلم بأمر العامة»، والحديث من رواية أنس بن مالك، ورواه أحمد بمسنده، وصححه الألباني.
هذه هي الظاهرة السوشلية، لا ترتبط بمعنى، ولا تحقق غرضًا، والواجب علينا جميعًا تأسيس وعي يجعل لهذه الثرثرة حدودها الطبيعية، لأن غزوها، وتحويل كل شيء إلى تفاهة متداولة بمنابرها يفرغ كل عمقٍ بهذا العالم، لأن الجمال بكل مجالاته الفنية والأدبية واللغوية لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق جذر، وأن يسقى جذعه بعمق واطلاع وفهم، لكن أن يتصدر كل شخصٍ ناتئ جاهل لإصدار النتائج والحقائق والقطعيات، وأن يضع نفسه ملهمًا ونبراسًا ودرسًا وأسًا، فهذه طامة كبرى، تدمر كل الجماليات الدنيوية التي بين أيدينا، إنه انحطاط وانهيار وجنون، وهذه المقالة هي إدانة لها.